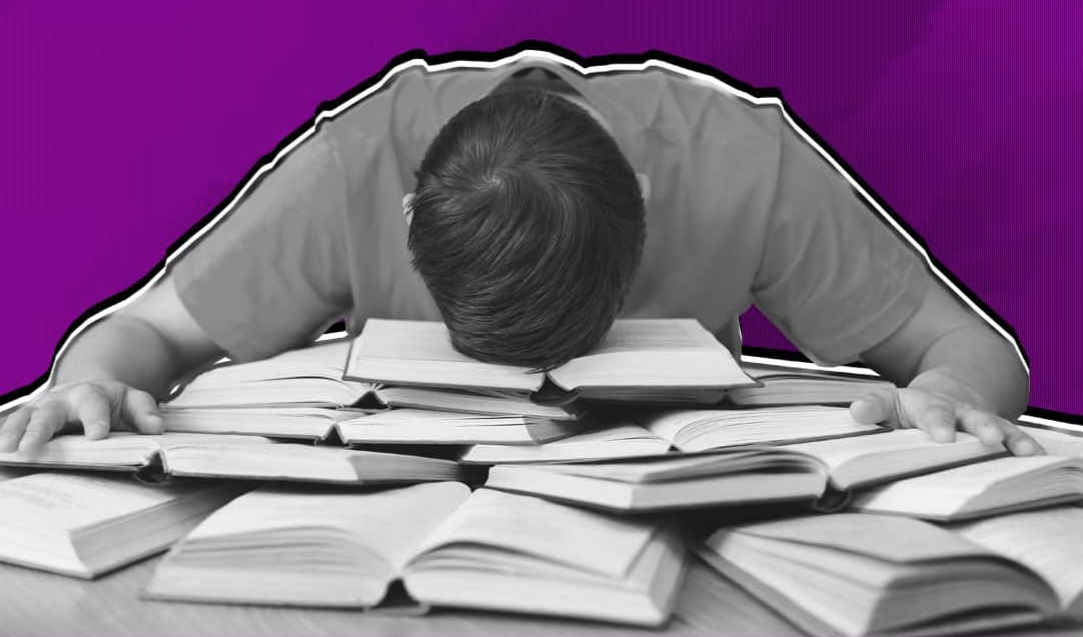"سنخرج من الاتفاقية ولكننا سنبدأ التفاوض وسنرى إذا استطعنا التوصل إلى صفقة عادلة... إذا توصلنا إلى ذلك فيسكون الأمر جيداً، وإذا لم نتمكن، فلا بأس في ذلك". بهذه العبارات المقتضبة أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، الانسحاب من اتفاق باريس حول المناخ الموقع في 12 ديسمبر عام 2015، والذي دخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، أي قبل أربعة أيام من انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، موجهاً الضربة الأقسى للاتفاق الذي نال صفة "التاريخي" لكونه أتى بعد سنوات شاقة من المفاوضات بين الدول الأساسية حول كيفية توحيد الجهود الدولية لمكافحة الاحتباس الحراري، وخفض انبعاثات غاز الدفيئة التي وصلت إلى أرقام قياسية. وهو ما يفسر حالة الاستنفار الدولي التي أعقبت قرار ترامب، والإجماع الدولي على التنديد به، بدءاً من فرنسا التي اختار رئيسها إيمانويل ماكرون، عقب وقت قصير من قرار ترامب، توجيه خطاب باللغتين الإنكليزية والفرنسية، خصصه للحديث عن خطورة الموقف الأميركي، وما يمثله من "خطأ بحق مستقبل الولايات المتحدة وشعبها وكوكب الأرض"، مروراً بالبيان الثلاثي الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والذي حمل رسالة واضحة برفض "إعادة التفاوض حول الاتفاق"، وصولاً إلى موقف الصين، التي تتصدر قائمة الدول الملوثة، ورغم ذلك أكدت الالتزام بالاتفاق.
جبهة الرفض لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق أو حتى فتح باب التفاوض بشأنه، والتي تشكلت بشكل تلقائي، فضلاً عن الإجماع على التحذير من خطورة القرار الأميركي وتداعياته الكارثية البيئية والسياسية، لا يمكن فهمها بمعزل عن أمرين جوهريين، الأول أهمية الاتفاق الهادف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض عبر خفض انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة، وخصوصاً أن القرار الأميركي سيؤثر سلباً على هذه الجهود لكون الولايات المتحدة مصنفة كثاني الدول الملوثة على الصعيد العالمي بعد الصين، وثانياً دلالاته على صعيد العلاقات الدولية والنهج الأميركي في مقاربة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً أن اتفاق 2015 لم يكن ممكناً لولا وجود إرادة سياسية لتحقيقه بالدرجة الأولى، وكان للجهود التي قادها الرئيس الأميركي في ذلك الحين باراك أوباما، فضلاً عن الصين وفرنسا، دور أساسي فيها. وهو ما يجعل من قرار ترامب ليس فقط انقلاباً على إنجاز أوباما الأهم خلال عهده الذي امتد إلى ولايتين بل انقلاباً على السياسة الأميركية في ما يتعلق بقضية المناخ أولاً والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ثانياً، الأمر الذي ستكون له تداعيات واضحة خلال الفترة المقبلة.
وبعيداً عن "الشق التقني" للانسحاب الأميركي، وكيفية دخوله حيز التنفيذ وتطبيقه، فإن القرار يكرّس الاعتقاد السائد داخل الولايات المتحدة وخارجها، بأن الإدارة الأميركية في عهد ترامب، التي تجنح نحو الانعزالية وتغرق في "شعار أميركا أولاً"، تساهم تدريجياً في تراجع دور الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، الأمر الذي سيتيح لدول أخرى أن تتقدم لتتصدر المشهد السياسي الدولي.
كما أن الإعلان عن الانسحاب مقابل إبداء الرغبة في إعادة التفاوض على "اتفاق أفضل"، ليس سوى تكريس إضافي لنهج ترامب الذي يفضل عقد "صفقات/ اتفاقات ثنائية" مقابل الابتعاد عن الاتفاقات متعددة الأطراف، على اعتبار أنه يرى في الأولى فرصة لتحقيق مكاسب أكبر، في حين أن الثانية تفرض تقديم كمّ أكبر من التنازلات للوصول إلى تفاهمات مشتركة.
وقد ظهر أن في جعبة الرئيس الأميركي الحالي، الذي وصل إلى البيت الأبيض رافعاً شعاري "أميركا أولاً" و"لنجعل أميركا عظيمة من جديد"، واللذين استشهد بهما خلال خطاب الانسحاب، العديد من الذرائع لتبرير قراره، والتي يمكن القول إنها تعكس ترجمة واضحة لمقاربته للقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وإن كانت تبريرات مثل قوله إن اتفاق باريس "لا يصب في صالح الولايات المتحدة"، وأنه لم يكن "حازماً بما يكفي مع الصين والهند"، يمكن أخذها بعين الاعتبار، فإن خطاب ترامب حمل ازدراء واضحاً باتفاق باريس تحديداً عندما قال "لقد انتخبت لتمثيل سكان بيتسبورغ وليس باريس"، أو حتى قوله "حان الوقت لإعطاء يانغستاون وأوهايو وديترويت وميشيغن وبيتسبورغ، وهي من أفضل الأمكنة في هذا البلد، أولوية على باريس وفرنسا". كما أكد ترامب أن اتفاق باريس "لن يكون له تأثير كبير" على المناخ. وهو الموقف الذي كان ترامب صريحاً خلال حملته الانتخابية في التعبير عنه، إذ لم يتردد في وصف تغير المناخ بالخدعة، مشككاً في الأساس العلمي للظاهرة، فضلاً عن وجود قناعة راسخة لديه بأن القيود البيئية على الشركات تجعلها أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمية، وهو ما يعني عملياً، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، إعادة الزخم للطاقات الأحفورية مثل الفحم والنفط والغاز. ويطيح هذا التوجه بهدف اتفاقية باريس ويعزز الانقلاب على السياسة الأميركية التي حاولت إدارة باراك أوباما إرساءها. وقد دفع هذا التوجه أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، إلى الرد بشكل مباشر على قرار ترامب خصوصاً في ظل قناعة الإدارة الحالية بأن أوباما تفاوض على اتفاق باريس بشكل سيئ، وبأن الاتفاق، كما وصفه ترامب، "مثال آخر على دخول واشنطن إلى اتفاق يضر بالولايات المتحدة".
وفيما ذكّر أوباما ترامب في بيان أصدره بأن الاتفاق لم يكن ليبصر النور في 2015 إلا بفضل "القيادة الأميركية على الساحة العالمية"، ندد كيري بـ"تخل غير مسبوق عن زعامة أميركا"، معتبراً أن البلاد "ستدفع ثمنه على صعيد النفوذ" الدولي، مشدداً على أن الخروج من اتفاق المناخ "يعزل الولايات المتحدة بعدما وحدنا العالم" عند توقيع الاتفاق.
رؤية أوباما القائمة على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة في الطليعة وقيادة الجهود الدولية المشتركة لمكافحة الاحتباس الحراري، ترجمت خلال عهده على أكثر من صعيد من دون التخلي عن المصالح الأميركية، لكن المشاركة في هندسة اتفاق باريس كانت التعبير الأوضح عنها، فضلاً عن إطلاق إدارته "خطة الطاقة النظيفة الأميركية" في عام 2015 والتي جاءت بعد سنوات من تحديد إدارته هدفاً بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 26 إلى 28 في المائة بحلول العام 2025 مقارنة مع 2005.
وتجلت رغبة إدارة أوباما في قيادة هذه الجهود من خلال تأكيده مراراً على أهمية العمل الجماعي للتصدي لقضية التغيير المناخي، وعدم التعارض بين الاقتصاد القوي والبيئة النظيفة. كما أنه لم يتردد في الخطاب الذي ألقاه خلال افتتاح قمة المناخ في باريس في الإقرار بدور الولايات المتحدة بالتسبب في المشكلة. وقد جاءت هذه المواقف لأوباما تتويجاً لما يعتبره انتصاراً لجهود إدارته في هذا المجال، بعدما اصطدمت مراراً بعوائق عدة من لوبيات الطاقة وصناعة النفط والغاز وصولاً إلى حد اتهامه بشن حرب عليهم.
لكن هذه الاندفاعة تمت، سواء في عهد أوباما أو من سبقه من الرؤساء، من دون التخلي عن المصالح الأميركية، وهو ما كان قد ظهر بشكل جلي في قمة كوبنهاغن للمناخ عام 2009، والتي انتهت بعد خلافات امتدت لأيام، بتوافق خلف الأبواب المغلقة، بين الملوثين الأكبر، أي الصين والولايات المتحدة، على اتفاق راعى مصالحهما وأثار استياء دول أخرى، خصوصاً بعدما كرّس مبدأ "المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة"، نص في جزء منه على تقديم الدول المتقدمة مساعدات مالية عدها البعض بمثابة "رشى" يومها بمليارات الدولارات للمساهمة في مواجهة الدول الفقيرة، والأكثر تضرراً من تغير المناخ، بسبب المخاطر التي تتعرض لها.
كما أن الولايات المتحدة، وفي مختلف العهود، وضعت مصالحها في المقدمة، لكنها لم تكن تتخلى عن وجودها دولياً بما في ذلك عبر طرح عدد من المبادرات، إذ كانت السباقة للدفع باتجاه طرح نظام مقايضة الحصص أو ما يصطلح على تسميته بـ"تجارة الانبعاثات"، على غرار ما حدث في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. ويقوم هذا النظام على وجود "حصص" محددة لانبعاثات غازات الدفيئة لكل دولة، على أن يكون جزء من حصة دولة ما قابلاً للبيع إذا كانت كمية انبعاث غازات الدفيئة لديها أقل من الحصص المحددة لها. في موازاة ذلك، يحق للدول التي تحتاج إلى "حصص" إضافية من انبعاث الكربون أكثر من الحد المسموح لها شراء حصص دولة أخرى مقابل بدل مادي. وقد طبق هذا النظام بين الدول وبين الشركات. وعلى الرغم من اعتماد المقترح في بروتوكول كيوتو، إلا أن الرئيس السابق جورج بوش الابن لم يجد حرجاً من الإعلان في عام 2001 أنه لن يلتزم بالبروتوكول بسبب التحفظات عليه واعتباره ظالماً.