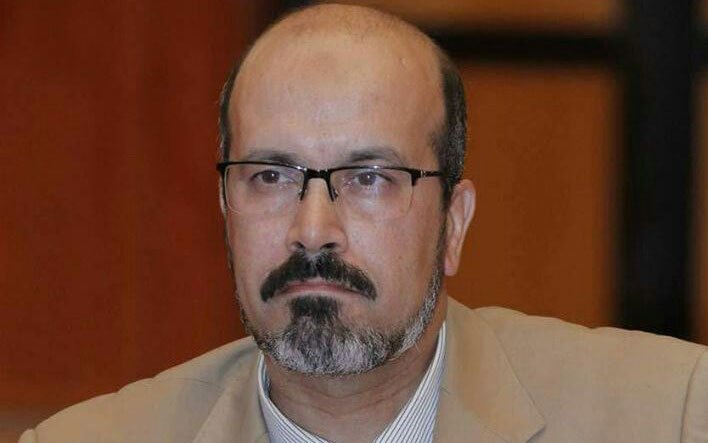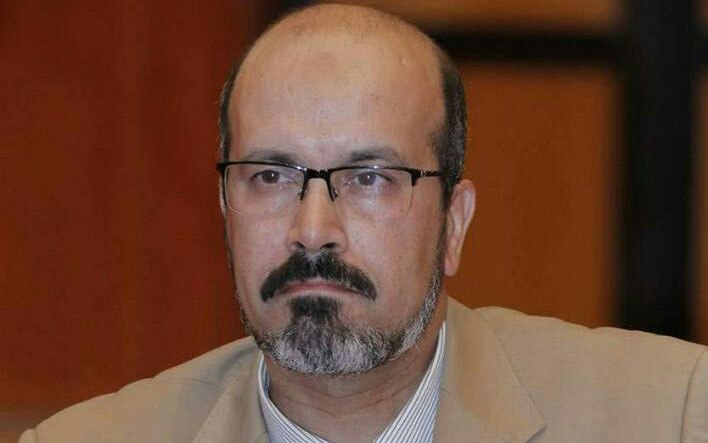يبدو أن الرأسمالية اليوم أصبحت في خدمة الحروب، حيث كل ما تنتجه الآلة الرأسمالية أو تبتكره، إلا و قد يُستخدَم لأغراض عسكرية، فجل الابتكارات الرأسمالية المعلوماتية، تم توظيفها لخدمة أغراض عسكرية، مثل الكمبيوتر والهاتف الجوال والانترنيت التي تعتبر اختراعا عسكريا بامتياز، إذ واجهت عند بداياتها تحت مسمى ARPANET احتجاجات طلابية بالجامعات الأمريكية، حيث رفض الصف الطلابي في ستينيات القرن المنصرم هذا الاختراع الجديد، ذلك لأنه يقوض الإرادة الجماعية، و يتجسس على المواطنين، و يقمع الحركات الاجتماعية الصاعدة.
يبدو أن الأمريكي في منتصف القرن الماضي كان أفضل وعيا من جيلنا الذي يطبل لكل اختراع معلوماتي، و يستهلك البضائع دون خلق مسافة واعية تساعده على النقد والتساؤل بشأن ما يلج السوق. لقد تنبأ الطالب الأمريكي منذ عقود لخطورة الشابكة، من حيث ما تشكله من قاعدة معلومات ضخمة، قد تستخدم لأغراض عسكرية، وما نشاهده اليوم من فضائح لغوغل والفايسبوك وغيرها من المنابر على الانترنيت، إذ تقوم ببيع بيانات مستخدميها لشركات ومؤسسات حكومية، ما هي إلا الثلث الظاهر الذي طفا فوق سطح الثلوج، أما الباقي، فيحتاج منا الغوص في أعماق الشابكة لكي نكتشف أن هذه المنابر تتعاقد مع المؤسسات العسكرية الأمريكية، بل من المنابر من تم اختراعه من طرفها قصد توظيفه لأغراض تجسسية. ولنعود بالقارئ إلى سنة 1972، لما تمكنت ARPANET آنذاك من تغطية جميع التراب الأمريكي، فتم استخدامها لمساعدة CIA و NSA و باقي المؤسسات العسكرية في تزويدها ببيانات المواطنين، خصوصا إبان الحركات الاحتجاجية التي عرفتها أمريكا ضد الحرب على لفيتنام، و تسربت الأخبار إلى الصحافة لتشكل فضيحة مدوية، حظت بتغطية خاصة على شبكات NBC.
و في السياق نفسه، نتساءل عن حمى التسلح ودوافع ارتفاع وثيرته بالعالم العربي على الرغم من أن إسرائيل لا تشكل هدفا عسكريا بالنسبة للجيوش العربية على الإطلاق، بل هناك من الحكومات والبرلمانات العربية من تناقش التطبيع من عدمه مع هذا الكيان الصهيوني، إذن لماذا أصبحت الدول العربية تنفق الملايير من الدولارات على التسلح؟ هل يتم إنفاق هذه المبالغ بدافع الخوف من خطر التهديدات الخارجية، وعن أي تهديدات نتحدث: هل يتعلق الأمر بقضايا "الإرهاب" و النزاعات الإقليمية، و الخطر الإيراني، والحركات الانفصالية، أم هي مكوس، يأخذها الفتوة الأمريكي والأوروبي و الروسي، حتى يتمكن من تقديم الحماية لشعوبنا، و ضمان استمرارية مؤسسته العسكرية، إذ بفضل هذه الهبات والإنعامات، لا يصاب اقتصاد الفتوة بالشلل، ولا تعلن شركاته الإفلاس، و لا يتم تسريح الملايين من العمال والمتدخلين في صناعة الأسلحة وتجارتها.
في عهد الحكم الشعبوي للسيد ترامب، سقطت ورقة التوت عن النوايا الحسنة الأمريكية، وعن شعاراتها الطنانة في دمقرطة العالم، ونشر قيم الحرية و حقوق الإنسان، إذ بعد غزو العراق و الإطاحة بنظام "الديكتاتور"، كما جاء على لسان بوش الإبن، استبشرت الحكومات العربية خيرا، و هي تنتظر بفارغ الصبر أن تسطع ديمقراطية الدبابة في سماء بغداد، فإذا بالعراق، تحول إلى مسلخة، تُذبّح فيها القوميات والأعراق و الطوائف الدينية (وقس على ذلك الحالة الليبية)، و هكذا ارتفعت تكاليف الحرب، حيث قام العداد الأمريكي بإحصاء النفقات الباهظة في فاتورة، وُجّهت كالعادة لدول عربية بعينها كي تغطي نفقة هذا الاجتياح، و هل ستسلم الحكومات العراقية الراهنة واللاحقة من إرث هذه الديون الأمريكية التي تثقل كاهل اقتصادات الدول العربية؟ انظروا ماذا حصل مع قطر؟ لقد صنفها الفتوة الأمريكي بوصفها دولة راعية للإرهاب، حتى دفعت ثمن الفاتورة ليغير من لهجته نحوها، و أصبح يداعبها بمعجم سياسي نقيض، وفي السياق نفسه، من يدفع الآن فاتورة "المساعدة الإنسانية" التي تقوم بها روسيا في سوريا؟ هل يؤدي ثمنها بشار من خزينة شعبه المعذب المكلوم، أم تدفعها إيران من عرق الضعفاء والبؤساء في وطنها المنسي، وهل سيسلم من تبقّى من الشعب السوري من فاتورة الحرب في حال التوصل إلى تسوية سياسية في المستقبل؟ هل سيتنازل الدب الروسي و الجاموس الأمريكي عن حقهما في تركة الرجل الهالك؟
لقد سقطت الدول العربية اليوم في مأزق اقتصادي خطير: إما أن تستمر في ضخ الأنابيب وحشو الأوراق النقدية ببطن الأخطبوط العسكري، حتى تساهم في الحفاظ على تركة عسكرية خلفتها الحروب العالمية بدعوى الحاجة الملحة في الحماية، و إما أن تتجاهل هذا الإرث، و تلتفت بالأحرى إلى جيوش العطالة و مشاكلها الاقتصادية المحلية، مما يبدو حلا سهلا، لكنه شبه مستحيل. هل تظن عزيزي القارئ أن المؤسسة العسكرية العالمية ذات المشروع الكولونيالي، سوف تتخلى ببساطة عن هيمنتها الاقتصادية، و طموحاتها السياسية و الجيو إستراتجية في السيطرة على المقدرات البشرية و الطبيعية لدول العالم الثالث؟ انظر كيف توفر دولنا و دول آسيا عمالة رخيصة يسترقها النظام الرأسمالي العالمي بأشكال متنوعة تحت مظلة ما يسمى بالتنمية البشرية!؟ انظروا كيف أنفقت السعودية المليارات على الأسلحة، و تركيا أصبحت قوة عسكرية في حلف الناتو، و المغرب اشترى قمرا اصطناعيا لأغراض عسكرية، ولائحة الدول المتخلفة التي تلهث وراء الأسلحة تكاد لا تحصى
نحن اليوم في العالم العربي نموت و نفتخر! فحكوماتنا توفر لكل مواطن قرص أسبرين و عبوتين ناسفتين و سلاح رشاش، كما توفر لكل قرية مستوصفا و دبابتين!؟
إنها كارثة التسلح بجميع المقاييس! هل الرأسمالية العالمية في حاجة ماسة إلى هذا النوع من الاستثمار لكي تستمر؟ من يدفع الكلفة المادية و البشرية لهذه الحروب الميكروية التي اشتعلت في الشرق الأوسط، والتي ستأكل نارها مناطق أخرى في إفريقيا وآسيا؟ و من يسير العالم اليوم؟ هل تسيره النخب السياسية المنتخبة أم المؤسسات الاستخباراتية العسكرية؟ إن السيناريو المصري يشكل خير دليل فاضح لما يقع في العالم الآن؟ إنه الجنرال العسكري الذي يلبس قبعة السياسي، ويحكم البلد؟ فإذا قام الفريق السيسي بهذا السلوك بشكل علني في مصر، فذلك لأن الشعب انحنى منذ زمن لحكم العسكر، أما في أمريكا، وغيرها من الدول "الديمقراطية"، فيظل المخطِط العسكري يسير القرار السياسي سرا، عبر التقارير والتوصيات و غيرها من الوثائق السرية التي ترسم إطار العمل السياسي بالبلد.
إن السؤال الملح اليوم الذي يتوخى البحث و التنقيب: هل جنرالات العسكر تسعى للحفاظ على مكتسبات مؤسساتها العسكرية، فتضع بذلك من أولوية أولوياتها ضخ الأموال في ميزانيات الجيوش حتى تتمكن من بسط سيطرتها على المجتمعات؟ و إذا كانت مصر والجزائر مثلا يسيرها الجنرالات، فهل باقي دول العالم، ومنها المغرب مثلا، يسيرها السياسيون المنتخبون؟
إنه خريف الشعوب العربية و انتكاستها: كيف تشترى أسلحة و أقمار اصطناعية بأموال الفقراء والضعفاء والمحتاجين؟ كيف تنفق ميزانيات هائلة على الجيوش بدعوى صيانة الحدود، و الدفاع عن الأوطان في انتظار أخطار غودوية تحمل عنوانين براقة مثل مكافحة الإرهاب، و تحرير الشعوب، و إقرار الديمقراطية، و غيرها من الشعارات؟ هل قدر المدنيين الأبرياء محتوم في دفع الكلفة البشرية بعدما قاموا بدفع التكلفة المادية لاقتناء هذه الأسلحة، انظر مثال سوريا والعراق وليبيا واليمن؟ متى ستنتهي معاناة الشعوب العربية في اقتناء الأسلحة و إثقال كاهل ميزانية دولها بشراء خردة من العتاد، قد لا يُقدَّر لها أن تُستعمَل أبدا؟ هل نحن اليوم نمر بظروف تاريخية طارئة، تحتم علينا شراء الأسلحة، أم نحن نعيش مشاكل ذات طابع بنيوي، تكمن في تسليح الرأسمالية قصد استمرار اقتصادها العالمي؟
إذا سلمنا بأن تجارة الأسلحة تشكل الشرايين المغذية للاقتصادات العالمية، فهل ما يقع اليوم من حروب هو من محض الصدف، أم هو من إنتاج خيال المُخطِّط العسكري الذي لا يستطيع أن يعيش بدون خلق توترات، يستفيد منها رواج الأسلحة، و تحافظ على استمرارية اليد العاملة في القطاع، وتنتشلها من الضياع ! فلنأخذ مشروع ARPA بالولايات المتحدة تحت قيادة ويليام كودل في ستينات القرن الماضي على سبيل المثال، حيث طاف الرجل أمريكا قاطبة مخاطبا الدوائر السياسية الرسمية بضرورة الاستعداد إلى جيل قادم من الحروب لا يحتاج تطوير قوة نووية، لأن مستقبل أمريكا الحربي لن يتجلى في خوض معارك نظامية، ولكن في خوض حروب ميكروية صغيرة، مما يتطلب من المؤسسة العسكرية الأمريكية إنشاء قاعدة بيانات ضخمة، و تجنيد العلوم الاجتماعية، لمراقبة ثقافات الشعوب التي تقع تحت سيطرتها و دراستها دراسة علمية قصد رصد منابع التمرد، ومواجهته. كيف توصل كودل إلى هذه الاستنتاجات، هل هو نبي زمانه؟ أهي نتائج البحوث التي قام بها مشروعه تحت عنوان Agile في آسيا؟ أم هو مخطط عسكري تم طبخه في دهاليز المؤسسة الأمريكية العسكرية؟ أم هو مزيج لهذا وذاك؟ هل يمكن اعتبار أحداث الربيع العربي والحرب على الإرهاب امتدادات لمشروع مكافحة العصيان (counterinsurgency project) الذي بدأه وليام كودل، عميل الاستخبارات الأمريكية في القرن الماضي؟ هل انبثقت هذه الظواهر الاجتماعية اليوم نتيجة ظروف تاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية محضة، أم تم تهييء الظروف المواتية، وخلق المراتع الخصبة لنشوء مثل هذه القلاقل؟ هل يمكن تعميم استعارة بنكيران على عالم السياسة اليوم، فنقول: "السياسي الذي يمثل الشعب يسود رمزيا، بينما العفاريت والتماسيح تحكُم"؟
ذ، محمد معروف ، جامعة شعيب الدكالي