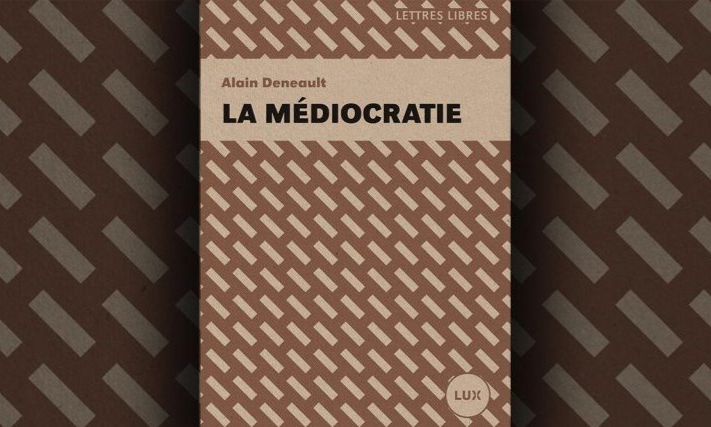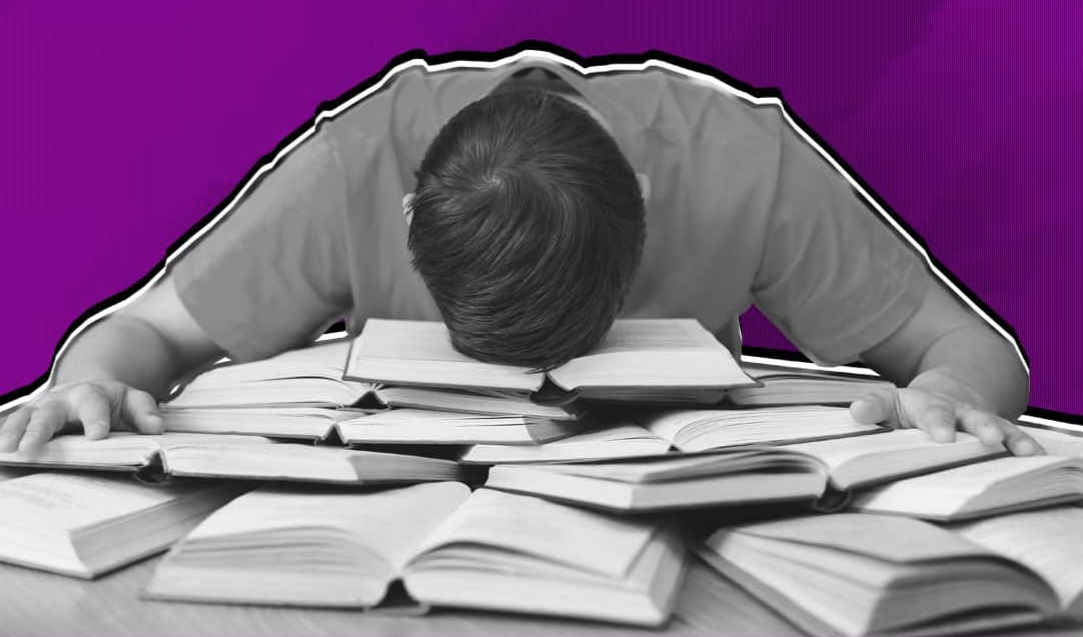كان من المفروض أن تعرف الجزائر انتقالا ديمقراطيا في سنة 1988، إثر الأحداث الدامية لشهر أكتوبر التي خلفت 500 قتيل، حسب تقارير منظمات حقوقية جزائرية ودولية، وذلك بسبب ندرة ونقص المواد الغذائية بالأساس و تدهور المستوى المعيشي بصفة عامة.
وقد أجبرت هذه المظاهرات التي عمت أغلب المدن الكبرى الجزائرية ولاسيما العاصمة، السلطات الجزائرية على تعديل الدستور واعتماد سياسة إنفتاح سياسي بإقرار التعددية الحزبية في بلد كان الحزب الواحد يدير شؤونه، وكذا الاعتراف بحزب إسلامي في إطار صفقة مع قياديين إسلاميين بهدف تهدئة الأوضاع نظرا للتأثير الواسع لخطابهم على المواطنين حيث كانوا ينتقدون بشدة النظام من أعلى منابر المساجد.
وقد أعقبت كذلك هذه الأحداث عدة قرارات منها إعفاء مسئولين كبار في الحزب الواحد وإرغام حزب جبهة التحرير على إفراغ قصر الحكومة الذي جعلت منه مقرا لها وهي بناية ضخمة وسط العاصمة كانت مقرا خلال فترة الاستعمارللحكومة الفرنسية المحلية. وكان الحزب الواحد مصدر كل القرارات في بلد كان الجيش عضوا بارزا فيه ويشارك في مؤتمراته. غير أن العنصر الجديد في الانفتاح السياسي هو تأسيس حزب إسلامي " جبهة الإنقاذ الإسلامية" في مقابل إلتزام زعمائه بتهدئة الأوضاع خلال أحداث أكتوبر.
هناك عنصر آخر يستدعي الوقوف عنده ألا وهو تعيين رئيس المخابرات العسكرية آنذاك قاصدي مرباح رئيسا للحكومة لتدبير المرحلة الانتقالية.
ولا بد من التأكيد بأن الحزب الإسلامي الذي فرض الانفتاح السياسي إلى جانب فئات عريضة من الشعب هو نفسه الذي تسبب في التراجع عن التجربة الديمقراطية التي عمرت أقل من سنتين على أقصى تقدير لأن المد العكسي انطلق مباشرة بعد الدور الأول من الانتخابات التشريعية ل 26 دجنبر 1991 حيث صدر قرار منع حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ مرفوقا بسجن قادته ونقل مئات مناضليه إلى معسكرات في جنوب البلاد ثم خوض حرب بدون هوادة ضد مجموعات مسلحة قريبة من الحزب الإسلامي طيلة عشر سنوات خلفت 300 ألف قتيل و40 ألف مفقود إضافة إلى خسائر مادية تقدر بالمليارات.
لا بد من التساؤل عما إذا كان ضروريا دفع هذا الثمن من أجل استعادة الأمن في البلاد .
وقد أرغم الجيش الجزائري الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة، واعتمد سيناريو للانتقال مدعيا أن الأمر -أي الإستقالة- غير وارد في الدستور وذلك لتفادي احتمال إعادة انتخاب الإسلاميين إذا ما أجريت انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر وإذا ما حل محل رئيس الدولة المستقيل ، رئيس البرلمان ، وهو الذي كذب الرواية الرسمية آنذاك التي ادعت أن الرئيس الشاذلي بن جديد قام بمشاورات مع رئيس البرلمان حول حلّ المجلس، طبقا للدستور. وبهذا يكون الجيش قد أوقف المسلسل الديمقراطي بدعوى أن الإسلاميين سوف يعودون بالبلاد إلى القرون الوسطى، مع العلم أن الدستور الجديد ، الذي وافق عليه الشعب الجزائري يقرّ بعودة الجيش إلى الثكنات والابتعاد عن السياسة.
وبعد ثلاثين سنة، تجد الجزائر نفسها من جديد في أحضان أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، بعد أن لجأت الحكومة إلى إصدار أوراق نقدية لتمويل العجز مع العلم أن مداخيل المحروقات بلغت خلال العشرين سنة الماضية 800 مليار دولار ، أي ثروة هائلة، كان بإمكان الجزائر أن توفد مواطنين إلى القمرعلى مثن أقمار اصطناعية. لم يبق منها إلا 30 أو 40 مليار دولار.
وبعد 30سنة عن هذه الأحداث الأليمة، واستنفاد أربع ولايات رئاسية، يقترح اليوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، مخططا لانتقال سياسي جديد نحو جمهورية ثانية يتعهّد بتولّي تدبيره إلى النهاية الشيء الذي سوف يتطلب أكثر من سنة ونصف على أقلّ تقدير. وهذا يفترض استمراره في مزاولة مهامه الرئاسية، علما أن هذه الحالة غير منصوص عليها في الدستور.
وقد يتساءل الملاحظون في الجزائر وخارجها عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذا الورش الكبير في وقت سابق وقبل نهاية عهدته الرابعة.
هل يريد الاستمرار لبعض الوقت حتّى يدشّن شخصيا وكرئيس دولة، المسجد الأعظم الذي يشيّده منذ سنوات على شاطئ العاصمة مثل مسجد الحسن الثاني مع إضافة بعض الأمتار في علو الصومعة بالمقارنة مع مسجد الدار البيضاء الذي دشّن منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقدّرت تكاليف هذا الإنجاز بأكثر من 2 مليار دولار أو أنه يريد تحطيم الرقم القياسي لسابقيه على أعلى هرم الدولة حيث قضى 20 سنة بقصرا لمرادية بالمقارنة مع هواري بومدين 14 سنة أو الشاذلي بن جديد 12 سنة.
مرة أخرى ، فهل سينجح الرئيس بوتفليقة في تمرير مقترحاته والإستمرار في تسيير دواليب الدولة، أم أن الشارع الجزائري سيفرض انتقالا فوريا وشاملا .
أما بالنسبة لدول الجوار ، فإن تطور الأوضاع في هذا البلد سيؤثر لا محالة عليها في جميع الأحوال.