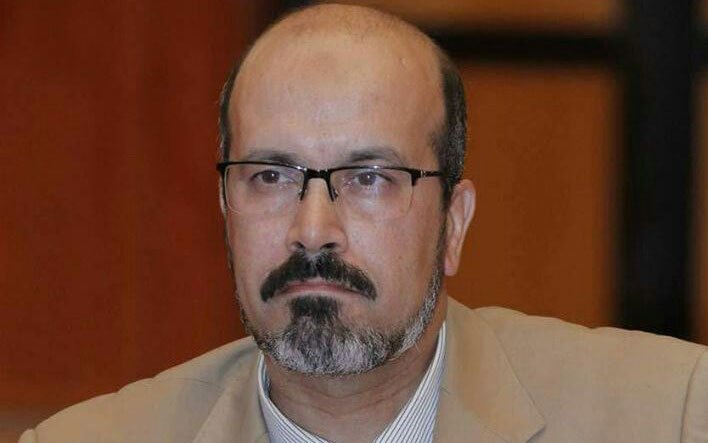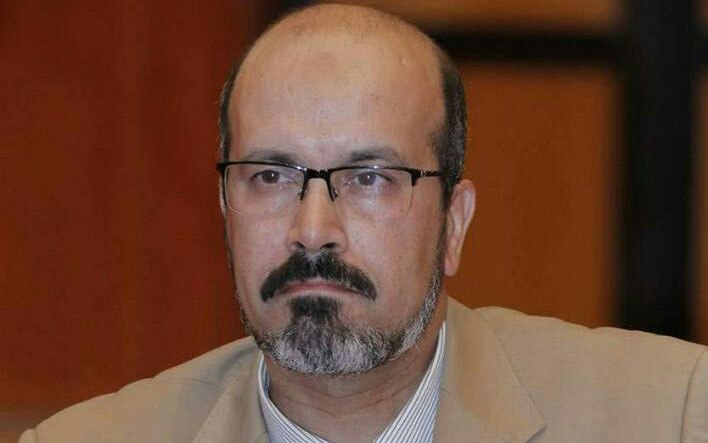في اليوم العالمي للشعر
الشعر محبة ولا يمكن أن يكون إلاَّها، ينسج من غُلاَلاتِ الضوء، وضفائرالأزهار وريش الأطيار ما يستعين به على إقامة وجوده في الوجود، في هذا العالم المترامي، ويرسم بدم كلماته الخضراء أو الزرقاء أو البنفسجية، حسب سياقات الدهشة والإدهاش، أفقا يتقاطع فيه صدى السلالات والجغرافيات المتحدرة من ليل الأزمنة وغبش الطبيعة والثقافات، بدبيب المرئي واللامرئي، وبالخبيء الذي يتلامع أو يتغامض في البعيد والأبعد واللانهائي. إنه بتعبير آخر، مواجهةٌ، رُغْم هشاشتها، ومقاومةٌ رغم حريريتها، لأشكال البشاعة والموت والدمار والخراب. تَحَدِّيهِ مكنونٌ في طفولته الغضة الدائمة التي لاَ تَنِي تتسلق الأشجار، وتقطف الورد، وتخطف القبل، وتعبث بالأعشاش، وتستدرج الطيور، وتستبق الظلال الرَّوَّاغة إلى المكعبات الملونة والدوائر الشهية حيث المجهول شبح عائم في الأسرار، وحيث الإصرار مركب نشوان يمخر أوقيانوس الرغبة الشاسعة، أوقصبات ممشوقات تصهل كمثل المهاري في براري الوجدان.
وإذا كان الشعر بعضاً من هذا، أَفَلاَ تقع على عاتقنا مسؤولية تلقينه للأجيال الصاعدة، وتربيتها على محبته، إذ كيف نستطيع أن نُعَلِّمَ أبناءنا أن الماء لاَزَوَرْديٌّ، وأن الهواء برتقاليٌّ، والريح خضراءُ مثل الزُّمرُّد، والصمت يئز بالنحل، والورد يرى ويبتسم، من دون أن نعلمهم لغة الشعر، اللغة العليا، لغة القول الرفيع، والكلام الأمير؟.
دَعْكَ من المختبئين وراء النظارات السوداء السميكة، المجذورين، المُزَرِّرِينَ للحواسيب كل الوقت، المحركين لِرُولِيتْ العدم، المدججين حتى الأسنان بالأرقام والحسابات البلهاء، المصطفين في طوابير لا تحصى بحثا عن التجشؤ، وسعيا إلى البِطْنة والأبناك وتركيم الذهب والحجارة. فإذا كانت الديمقراطية والحداثة مطلبين لا مناص منهما لتأهيل بلادنا وتبويئها المتوخى، فلا أقل من أَنْ تَتَبنَّكَ المعرفةُ والأدبُ والشعرُ رأسُ الرُّمْح فيهما، المكانةَ الأنسبَ، والمرتبةَ الأَسْنَى في البرامج والمناهج التربوية لتأهيل الإنسان، وربح الغد والرهان.
لقد ظل الشعر، الذي أصبح له عيد أممي سنوي عبر الكوكب الأزرق، مصاحبا للإنسان، ظلا ورفيقا وأنيسا، نَاياً ولساناً في سمع الأحقاب والأيام، في زمن يستغني عن الإنسان.
من هنا، ضرورة مديحه والتمسك به، والاستمساك بروحه وريحه وريحانه ضد الصدإ، والتآكل، والتعذيب، والظلام. حقا، إنَّ الشعر لاَ يَقْدر أنْ يطعم مُتضَوِّراً ظمآنَ، ويكسو طفلا عاريا غَرْثانَ، أو ينش عن جراحه وأوساخه الذبابَ، ويوقف الحروبَ، ولكنه، يستطيع أن ينخس الحشاشات، ويعذب آذان الكون بالصراخ العالي، والصدر العاري، ويستفز الضمير والوجدان، ويخاطب ما بقي من آدمية ـ إنْ هي بقيتْ- في مُشْعِلي الحروب، والخفافيش المخيفة، بالكلمة الصافية الماسيّة، والحرف الأخضر الزمردي، والروح الهيمى واليقظى كل حين، والصدق المُزْهر، والرأي الثاقب على الحقيقة والمجاز، وبالسمو الذي تجسده اللغة الشعرية ـ لغة الأنبياء والقديسين والمتصوفة ـ التي تشهد على " زمننا وعلى الآلام الكبرى لزمننا ".
إن الشعر هو طفولة دائمة ومتجددة، إنه عودة بالعالم إلى ما قبل اللغةِ فيما قَالهُ الشاعرالفرنسي الكبير إيفْ بونْفْوَا ونحن على مائدة عشاء ازدانتْ بحضور بَاخُوسَ ذاتَ ليلٍ روحاني عميق بين أحضان قصر أندلسي مُنيفٍ في فاس الأبدية.
فليكنِ الشعرُ لغتنا –في الغدو والرواح، وحتى بعد الموت-، لغة الضوء، والنور، والسلم، والحرية، والإخاء، والمحبة حتى نَسْمُوَ على ضَعَتِنا وَوَضَاعَتنا، وصلصالنا الفاني، والذئب الذي فينا. لنحبَّ الشعر كي نحب الآخرين.
ويا أحبابي الشعراء في كل أصقاع الدنيا، طوبى لكم وأنتم تفنون لتضيئوا جنبات الكون، والجهات الست، وتغمروا بالمحبة كلها هذا الغمر المترامي، وهذه " البرتقالة الزرقاء " المتراحبة، على حد تعبير الشاعر بولْ إيلوارْ.