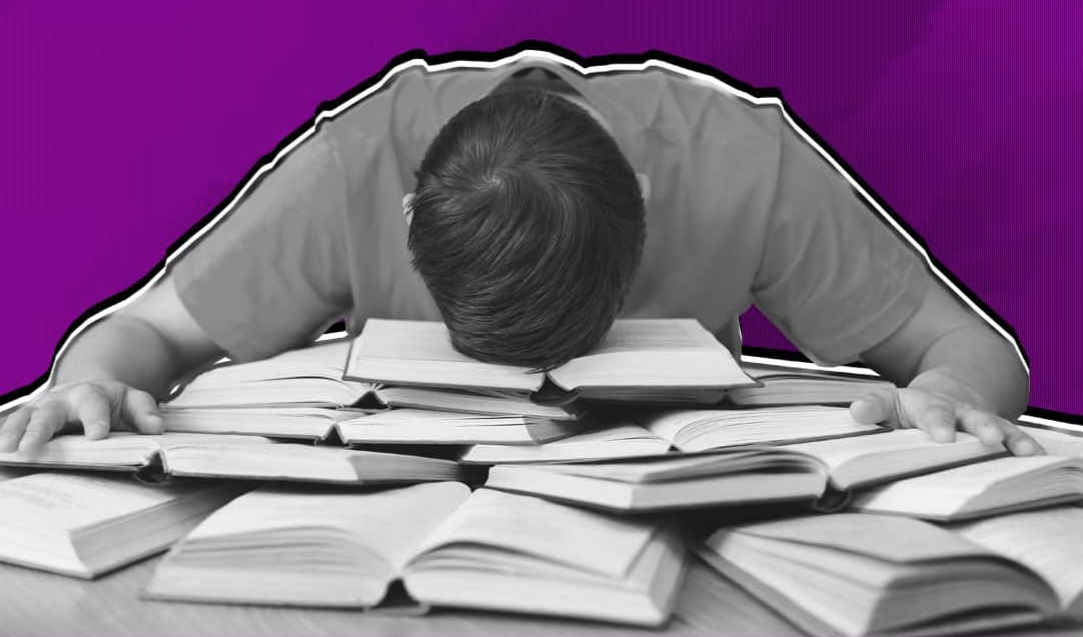بل هي انكفاءات مستدامات، ووهم نعامات سرعان ما تنقلب إلى سبات، وتتحول إلى تثاؤب مزمن. فكأن قدر الأمة العربية والإسلامية، اقتضى ذلك، و"العناية السماوية" ارتأت أن يظل هذا النوع البشري، والصنف الآدمي على ما هو عليه، على ما كان وما يأمل أن يكون: وحيد عصره، وفريد زمانه. هذه الواحدية، وهذه الفرادة تنسحب على عصور متراكبة وممتدة، وتلك الواحدية على طينة بشرية هي "خير" طينة، و"أعطر" أرومة، و"أنقى" سلالة، و"أصفى" عين ونطفة.. النطفة التي تقلبت في الأرحام العربية، أرحام العرب العاربة، العرب الخلص، البيضان من كل سوء، لا العرب المستعربة المفتوحة والمغزوة والملحقة، على رغم صنعها "المجد" العربي في لحظات برقت، ومحطات تطامنت تسيد المسلمون فيها أغلب الأمصار والأقطار والجهات، وهيمنوا على زمنية الأمم الأخرى، وتاريخيتهم. هل كان ممكنا أن يحقق العرب المسلمون ما حققوه لو ظلوا بعيدين عن الاحتكاك بالمجتمعات والشعوب الأخرى؟.
هل كان ممكنا أن يفيقوا، ويعوا اشتراطات مغايرة، وظروفا مختلفة، ومناخات ثقافية، وإنجازات حضارية، لو لم "يفتحوا" عنوة أمصارا ومدائن وجهات ودولا وأمما، ذلك أن الرسالة المحمدية توجهت إلى إصلاح الشأن العربي العام، أي إلى تقويم السلوك، وتزكية النفس بالخلق الكريم، وتدبير المعاش اليومي في إطار من الأخوة الدينية، والانسجام العرقي، والتكامل القبائلي، والتضامن الطبقي والتكافؤ النسبي المحسوب والمنسوب على رغم استمرار نظام الرق والعبودية والاستعباد. رسالة الإسلام هي رسالة روحية سمت بالإنسان، ورفعته إلى سُدّة الآدمية، وارتقت به سلم التحاب، والتواد، والتعارف، والتساكن، وضمخته بالقيم العالية، قيم الصدق والإيثار، والتضحية، والتواضع، وغيرها. غير هذا، جاء من حضارات أخرى، وثقافات مختلفة أغنت الرسالة، وأمدتها بنسغ العلم والمعرفة والفنون والآداب، والفلسفة والطب والحكمة، والفلك، والرياضيات وغيرها. فالإسلام بعد "الفتوحات" و"الغزو"، و"الجهاد"، و"إعمال السيف"، اكتسى العالمية، وانتضى بيرق التقدم، وصار إلى ما صار إليه بفضل التثاقف والاحتكاك، والترجمة والتعريب، والنقل والغَرْف، وهَلُّم جرّا. تلك إفاقة أولى رسمت تباشير وعلائم الدولة الأولى، الدولة الإسلامية المكتنزة بالأعراق والسلالات واللغات المنصهرة. أقول الدولة الإسلامية لا الدولة الدينية بما هي متكثرة لا متفردة وعربية خالصة قرشية هاشمية وَمَنَافِية فيما يذهب المتربصون والانغلاقيون والمحنطون. إفاقة كان لها شأن وباع بما لا يقاس، قدمت للعالم ما كان به العالم آنئذ: المعرفة، والفن، والاكتشاف، والكتاب، والحضارة المشرقة. غير أنها إفاقة انطمست سريعا – فعدة قرون محسوبات مقيدات، لا يساوين شيئا في عمر الزمان –وانطفأت كأن لم تكن، وغط العالم الموضوع رهن سيادتها التاريخية، غطيطا عميقا ومديدا، ارتفع شخيره، فتصادت له الأنحاء والجهات. غطيط نتج عنه خوارق، ومعجزات، وكرامات فَبْرَكَها الكسل، والخمول، وعلماء التلاخيص والرُّقَع، وصدقها الجميع. تعطل الحس والحدس والعقل، فاستولى السبات، وَرَانَ طائر الموت الأسود أدْهُرًا على سماء البلدان الإسلامية، فيما نهضت أوروبا، وأفاقت، ولازالت ناهضة، ناجزة، تطاول الأزمنة والأمكنة، وتخوض الفتح العلمي تلو الفتح العلمي، لأنها حسمت في أمر الدين الذي كَبَّلَها، وأثقل مشيها زمنا طال واستطال كان من عقابيله أنهار من الدم، والحرق، وسحل "الساحرات"، وسمل أعين الأطباء والعلماء، وسحق العقل، والفكر التحرري، وكل نأمة تجديد، ونسمة هواء وتحديث. وقفت أوروبا على الهول والموت الزؤام الذي حصد الملايين من الناس، وأتلف البنيان والعمران. ولم يكن وراء هذا الهول الذي تشيب له الغربان، سوى الدين. فالدين –بهذا المعنى- جرثومة الفتن والتفرقة والعنصرية، والتحقير. إنه –بكلمة واحدة- سبب تأخر العالم المسيحي بأطيافه جميعا: بروتسانت، وكاثوليك، وأرثوذوكس، وآخرين. فالدين – بعبارة أخرى- يتضمن- الإقصاء، إذ أن كل طرف ينفي الطرف الآخر، ويُخَوِّنُه، ويُزَنْدِقُه، ومن ثَمَّ يدعو إلى تصفيته وقتله أو نبذه ونفيه، ضمن صنافة موهومة ومتوهمة وواهمة، يعتقد أصحابها أنهم الحق، وأن عناية السماء معهم، بل تكون انتدبتهم ليتكلموا باسم الله من أجل سحق خلق الله، هكذا، تنصلت أوروبا، ودول أسيوية تَمَسَّحَتْ، من هذه الضرورة، وهذا القسر، فاعتبرت أن الدنيا للناس، وأن الدين لله، ما يعني أن العقل والفكر البشري قمين بإعمار الأرض، وتوطين التشريع ووضع القانون الذي يحمي الناس، ويساوي بينهم المساواة التامة.
تقدمت أمريكا وأوروبا، وكثير من دول آسيا ــ ولاشك أن الديانة الوضعية في القارة الأسيوية، التي تقوم على السلام والمحبة والحكمة والغفران، أبعدت شبح التناحر بين هذه الشعوب إذ الأرضي أرضي، يستوي الكل فيه، ولا تفاضل بين الناس، ولا أحد يتكلم باسم السماء، فالأمر محسوم هناك -، تقدمت هذه الأمم بعد أن أدركت العائق الديني، فَنَحَّتْهُ من طريقها ودنياها، ومعاشها، فإذا هي كما نرى ونعيش ونعاين ونراقب.
أفاقت الأمة العربية الإسلامية بعد بَيَاتٍ شتوي استغرق خمسة قرون، في أحسن الأحوال، فسارعت إلى النهوض، واللحاق بالركب الأوروبي، من خلال البعثات الطلابية، ومن خلال الاستعمار الذي كان صدمة لها إذ عرى حقيقتها التي لم تكن غير حقيقة الضعف العام، والتخلف التام، والغَرق في يَمّ الجهالة الجهلاء، والسقوط في دَرَك الأوهام. نشطت آلة الترجمة والنقل، والاستنبات، وتوالجت بنيات التحديث الفوقية والتحتية في صراع مع الزمن، لكن الدين كان في المنعطف صخرة ضخمة تعترض الماشين، والزاحفين، والمهرولين الذين يريدون اللحاق بعد أن هالهم تأخر الأمة الإسلامية التي كانت "خير أمة أخرجت للناس" !، كان الدين تنّينًا ذا رؤوس متعددة، وألسنة / شُهُبٍ تقذف النار والشرر، تصدى للتقدم على بطئه، وللزحف على تثاقله، وللمشي على رِسْلِهِ وإمهاله، تصدى مقاوما عبر "علماء" و"فقهاء" تَلُوثُ الأصفارُ على رؤوسهم، وتَدِبُّ جُعَلُ الجهل فوق عمائمهم، وأدمغتهم، حيث اعتبروا العلوم النصرانية كفراً، والقائلين بها زنادقة ومرتدين، ومن ثم هَرْطَقُوا طه حسين، وأحمد أمين، وسلامة موسى، وشبلي الشميل، والطاهر الحداد، وقاسم أمين، وأحمد شوقي، ومدرسة الديوان، وأيولو، وجبران خليل جبران ومحمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، ونوال السعداوي، وفؤاد زكريا، وفرج فودة، وخليل عبد الكريم، ونصر حامد أبو زيد، ولويس عوض، وفاتن حمامة، وتحية كاريوكا، وسامية جمال، ونجوى فؤاد، وزيزي مصطفى، وأخريات وآخرين كثيرين، بل حتى الإمام محمد عبده لم يسلم من أذاهم وتحجرهم، إذ اعتبروه مهزوز الإيمان، مدسوس الإسلام، ولك أن تعلم على سبيل المثال، أن جنازة الإمام لم تتحرك طوال اليوم بعد أن اشتد النقاش حول الصلاة عليه من عدمها داخل الجامع الأزهر !!.
فالإفاقة المتأخرة التي جاءت في ركاب محمد علي باشا، وبعده، والتي جاءت في العصر الحديث أي مع أواخر القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين بمصر والشام تحديدا، سرعان ما انكفأت، وعلا تثاؤبها، لندخل سباتا جديدا، عَزَّ عليه أن لايكتمل السبات الأول المستطيل. وعلى رغم أن الاستيطان الكولونيالي ساهم بقسط في هذا السبات، فإن أهل الدار استطابوه، واستمرأوه، إذ لم يكن لهم حول ولا قوة ولا علم يبطشون به، ويقارعون، قصاراهم الدين ملاذا، و"الماوراء" ملجأ، والسماء مطمعا في إحقاق الحق، ومحق النسل الكافر، النسل النصراني واليهودي الذي كان وراء ما طَمَّ العرب، وَغَوَّصَ الرُّكَبَ. لسنا بغافلين عن الحراك الجماهيري، الذي هَبَّ لطرد الاستعمار في كل البلاد المستعمرة، يقودهم نُخُبٌ مفكرة، وقادة رأي ووطنية.
اندحر الاستعمار، وخرج يجر أذيال الخيبة كما يقال – من يجر الأذيال هم أم نحن؟- ولم نستفق، فكأن الإفاقة السريعة التي أعقبت الخروج، طمعا في امتلاك السيادة، واسترداد القيادة، واستعادة الأرض والمجد، مرت في القيل والقال، والاقتتال حول فكرة البناء، وطبيعة الوطن، ونوع السياسة والاقتصاد المطلوب لهذا البناء. جثم العسكر على أقدار دول عربية وإسلامية بما يعني انتشار الديكتاتورية والقمع، وكسر الرأس والعظام أي سلب الحريات، وَوَأْد أي تطلع إلى الديمقراطية.
جثم وَكَسَّرَ، فإذا الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والبيئية، تشكو الفقر والوضاعة والهشاشة، وإذا القلة الأوليغارشية جبارة مستأسدة بالمال والسلطة، وبالكومْبرَادُورْ الذي يلتقي معها موضوعيا، فيما الأغلبية تكدح وتشقى، وتكتفي بالفُتَات. سُبَاتٌ تَمَطَّى – إِذًا- حتى جاء "الربيع الخديج"، ربيع الهبات الجماهيرية في جل البلدان العربية – الإسلامية، ليهز الأركان المهزوزة أصلا، ويدك الأرض من تحت أقدام الجبارة "الكارطونيين"، الذين سقطوا كأوراق الخريف، وهربوا، واندحروا. وكان الدين مرة أخرى – في المنعطف متربصا، يتحين الفرصة ليجهز على الإفاقة العظيمة المتأخرة، فيعيد المستفيقين اليقظين إلى الكهف، إلى النوم والبيات، ممتطيا هذا الحراك الجسيم، مستفيدا من "اللخبطة" العامة، والاضطراب المهول، ليقبض على عنق اللحظة الذهبية، ويهتبلها فرصة مَاسِيَّة ظل يتحينها منذ أكثر من ثمانين سنة في وصية يتوارثها ربانيون عن ربانيين، وكان ما كان، كان حتى صعد نجمهم، وعلا سعدهم، فواتتهم اللحظة، ثم تسنموا السّنام، وارتقوا السُّلم المعجز، فإذا هم في قُمْرَةِ الرياسة والقيادة والسلطة، يأمرون، وينهون، معتبرين مصر العظيمة ــ وهم الأقزام- بيتهم لوحدهم، مصر سبيلا لاَحِبًا إلى الإمارة والخلافة. لا أقليات، لا أقباط ولا يهود، ولا يحزنون، المسلمون فقط، والمسلمون –لعلك مُنْتَبِهٌ- أصناف، أما الصنف المعصوم الذي حاز علم الدنيا والدين، علم الآخرة والغيب، والوراء، والماوراء، والخلف والفوق، فهو: الإخوان المسلمون الذين طار طائرهم، وانتشى دليلهم من دون أن يعلموا أنهم يُعَنْصِرُون البلاد، ويدعون جهارا نهارا، إلى الأبارتايد المقيت، والزج بمصر في وهاد التهلكة، والدفع بها إلى المجهول.
لكن الشعب –والشباب في طليعته – عاين بذهول- ما يجري ما جعله يسرع ويَسْتبِقُ الزمن ليخرج في ثورة شعبية قيامية يوم 30 يونيو 2013 قصمت ظهر "الإسلام هو الحل"، وظهر "الإخوان" الذين فشلوا في تدبير أمر مصر، وبان أنهم صغار ضعاف بينما مصر منيفة وعظيمة، وتاريخ متجذر وضارب قبل أن تكون الديانات. إنها إفاقة أخرى يتخللها الوضوح والغموض، الإبصار الحي، والقذى المؤلم الذي قد يقود إلى العمى، ما لم تأخذ مصر بزمام مصر، أي ما لم يعد المصريون العظام إلى الجادة، وينبذوا التفرقة، ويستأصلوا الإرهاب، ويضعوا مصير مصر بين يدي قادة رأي وفكر وعلم وسياسة وَحِلْم.
بغير هذا، أخاف على مصر، على أن تدخل سباتا مزمنا شبيها بِسُبات أهل الكهف، وَمَحْلاً سياسيا واقتصاديا، وثقافيا، مثيلا لذلك المحل التي شهده المسلمون في عام "الرمادة" وأعوام الجوع والطاعون خلال قرون ممتدة، وتواريخ سوداء.
وفي غرب العالم الإسلامي، في المغرب تعيينا، يقع انقلاب على أحد الحقوق الإنسانية الذي هو حق الحياة، فكأن مدونة الأحوال الشخصية التي ردت للمرأة بعضا من إنسانيتها، وكرمت كينونتها على مستوى جانب من هذه الكينونة، لم تنغرس عميقا في عقول ووجدانات النخب الدينية التي تنقض على المناسبات، والفرص لتنجز الردة الحقوقية، والثقافية، والحضارية. هذه الإفاقة الحقوقية التي استتب لها الأمر بعد لَأْي، يحاول السياسيون الربانيون باسم الدين، الالتفاف عليها والانقلاب عليها لتَسْبُتَ، وتعود المياه إلى مجاريها. أما تلك المجاري المخزية العطنة، فهي تزويج البنت في عمر ينزل عن 18 سنة. فهاهي لجنة العدل والتشريع، وحقوق الإنسان، بالبرلمان، تشهد حربا "ضروسا" ووطيسا بخصوص زواج الصغيرات، وفي المنعطف والثِّوَاء، يَكْمُنُ الدين أو بتعبير أصح، يُتْلع الرأس تأويل الربانيين لِلدّين بما يخدم التسليع، والشبق، ووطء "الطراوة"، بدعوى الحاجة، و تخليصهن من الفقر، ودعوى الرشد والإفاقة والوعي بالجسد ما بين سن 14 و16. والحال أن المبررات التي يسوقها فصيل سياسي إسلاموي، ما كان لهم سَوْقُها، لو آمنوا بحبة خردل من كرامة إنسانية، وتساءلوا: ما سبب الفقر والحاجة، والاضطرار الظالم؟، ما سبب الأمية والجهل؟ أليس سبب ذلك يرجع إلى الدولة، ممثلة بالحكومات المتعاقبة التي لم تستأصل آفة الأمية، ولم تنشر في الناس التربية والتعليم، إن حاضرًا أو باديا.
لقد تُرِكَ الكل في مهب الريح، تُرِكوا لمصائرهم، تركوا للقدر والمجهول، وتُركوا لِمصَّاصِي الدماء الشبقين، ولفقهاء الولائم و"الزّْرُودْ" والنكاح والمناكحة، إسْوَةً بالصحابة الكرام، والسيدة عائشة زوج الرسـول الأكرم التي بنى بها النبـي وعمرها تسع سنوات، علما أنها فَرْيَةٌ، وكِذْبةٌ كرَّسها تاريخ مصنوع، وعلماء التحريات الآن، والفحص والتمحيص، يقول بغير العمر المكرس، يقول بعُمر الرشد والوعي لا بعمر الصبا واللهو، والتأرجح بين أعذاق النخيل.
سـؤال أخير: هل تناقش البرلمانات الأوروبية، والأمريكية، والأسيوية والأسترالية، هذه القضية "الوجودية"، والمسألة "المصيرية" زواج البنت القاصر، الطفلة التي تُجَسْدِنُ اللهو، والمرح، والبراءة؟ هل تناقش تعديد النساء والحريم، و"ملك اليمين"؟، والإرث، وغيرها..؟.
أسأل، ولا أريد جوابا، فالجواب يثوي عميقًا أسيفًا، ركينا حصينا في البنية الذهنية الدينية، وفي التخلف البنيوي الحاد والعُضال والمزمن.