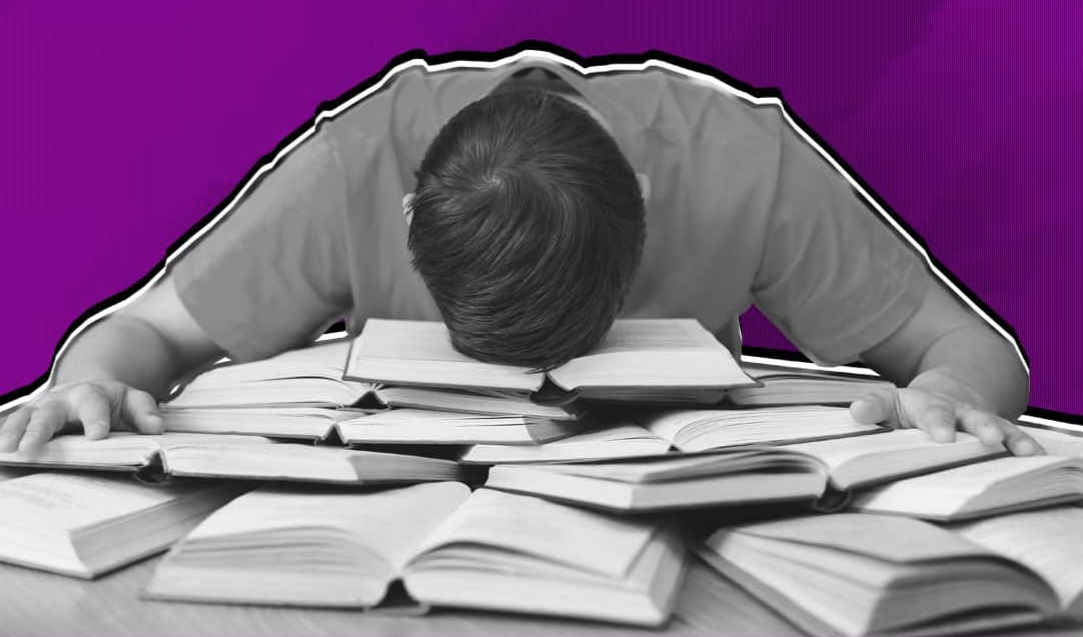مدينة مراكش العريقة - التي تحمل لقبيْن جميليْن اثنيْن هما "الحمراء" و"البهجة" – كانت قد اختيرت مؤخراً من طرف أحد المواقع العالمية للسّياحة (Travelers’ Choice Awards) كأوّل وِجْهة سياحيّة في العالم من بين ما ينيف على عشرين مدينة كبرى من عواصم العالم، متجاوزةً مدناً مثل إسطنبول، ولندن، وباريس، وروما، وهذا ما أكّده منذ بضع سنوات الكاتب الإسباني "فِرْنَانْدُو دِيَاثْ بْلاَخَا"، حيث قال في إحدى مقالاته: "إنّ هذه المدينة التي تُلقّب بالبّهجة والحمراء هي من أكثر المدن المغربية جذباً للسيّاح، على امتداد الحَوْل من مختلف أنحاء العالم".
ويرى هذا الكاتب أنّ التاريخ - في هذه المدينة التي أسّسها تأسيساً عام 1062 يوسف بن تاشفين، أوّل أمراء المرابطين - مازال حيّاً نابضاً، محتفظاً بأصالته، وماضيه، وبريقه، ورونقه، وإشعاعه وعاداته وتقاليده، وعوائده منذ عدّة قرون خلتْ.
وهو يؤكّد إنّه إذا كان هناك مكان في العالم أصبح فيه ماضيه حاضره، والذي توقّف فيه العصر الوسيط بكلّ سِحره، وبهائه وأساطيره، وخياله، فإنّ هذا المكان هو المغرب؛ وهو يستدلّ بذلك على مدى حقيقة التقارب والتداني اللذين يطبعان الشعبين الإسباني والمغربي على حدٍّ سواء بحكم تاريخهما المشترك، والموقع الجغرافي المتميّز للبلدين، خاصّةً بعد أن تشبّعت واغترفت أوروبّا، وشبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال) على وجه الخصوص، من الإشعاع الحضاري، والثقافي، الإسلامي الزّاهر زهاءَ ثمانية قرون.
ويؤكّد الكاتب الإسباني في هذا السّياق أنّ لإسبانيا مع جيرانها الثلاثة وهم: فرنسا، والبرتغال، والمغرب، مُعايشات، وصَوْلات، وجَولات، وذِكريات لمعارك، ومُواجهات انتصرت في بعضها وانهزمت في أخرى، فبالنسبة لفرنسا مازال الإسبان يذكرون غزو نابليون لإسبانيا عام 1808 ومحاولته تنصيب أخيه "خوسّيه بونابارتي" على التاج الإسباني. ومع البرتغال ما فتئ التاريخ يذكّرنا ولو بغير حدّة هذه المرّة بـ"حرب البرتقال" التي أعلنها السّخيف "مانويل غُودُوي" ضدّ إسبانيا وفرنسا عام 1801؛ في حين كانت مواجهات وعراك الإسبان مع المغرب أطولَ وأكثرَ شراسةً وضراوةً وقسوةً وعنفاً وعِناداً..!
عودة إلى الماضي البهيج
يقول الكاتب "فِرْنَانْدُو دِيَاثْ بْلاَخَا" بالحرف الواحد: "ولنتوقّف في القرن العشرين الفارط، ناسين، أو متناسين الحملة الأفريقية التي شاء وصادف الحظّ أن سُجِّلت بواسطة قلم "ألاَرْكُون"، ورُسِمت بريشة الفنّان "فورتُوني"، إنّه على امتداد هذا القرن لا تكاد تمرّ خمس أو عشر سنوات من دون أن يشعر الإسبان بوجود أو حضور جارنا في الجنوب (المغرب) بين ظهرانينا: ففي عام 1909 مواجهة "برّانكُو دِيلْ لُوبُو" (بالإسبانية) أو "وادي الذّئب" ( بالعربية) أو "أغزار نأوُشّن" بـ(الرّيفيّة حسب اسمه الأمازيغيّ الأصليّ)؛ وفي عام 1921 معركة "أنوال" الشهيرة، وفي عام 1934 مغاربة في أستورياس، وفي 1936 مغاربة في كلّ مكان، (خلال الحرب الأهلية الإسبانية التي اشتعل فتيلها عام 1936 وَوَضعت أوزارَها عام 1939)، وفي 1956 هجوم على سيدي إيفني، وفي عام 1975 المسيرة الخضراء، واليوم المطالبة بسبتة ومليلية، والجزر المحاذية للسّواحل المغربية" .
على الرّغم من كلّ ما سبق، وحسب هذا الكاتب، فإنّ المواطن الإسباني العادي لا يشعر بأيّ نوع من الحقد والضغينة نحو جيرانه "المغاربة" الذين اعتاد الإسبان أن يدعوهم بشكل عشوائي ومُبهم وببساطة الإخوة "لُوسْ مُورُوسْ" (!)، كما لو كانت أواصر الدم أقوى وأمتن وأعمق من ذكريات الحرب، والمواجهة والمناوشات.
إنّ المواطن الإسباني يذهب اليوم إلى المغرب بواعزٍ قويّ، وبفضولٍ غريب وبتطلّعٍ ولهفة، وهو بذلك يبدو وكأنّه يشرئبُّ بعنقه على شفا الزّمن ويطلّ على حافة التاريخ.. تاريخه الشخصيّ، أو ماضيه المشترك مع هذا البلد الجار.
من فاسُ إلى قرطبة
في معرض حديث الكاتب عن حاضرة فاس نجده يقول بالحرف الواحد: «أوقفتُ المرشدَ السياحيّ عندما هممنا بالدخول في زقاقٍ ضيّقٍ جدّاً من أزقّة هذه المدينة العتيقة والعريقة، وأنا أشير إلى عُودٍ أو عَمُودٍ من الخشب يتوسّط الزّقاق، وقلت له :
- هذا الشارع الضيّق يُغلقُ بالليل، أليس كذلك..؟ فأجابني المرشدُ على الفور :
- أجل، ولكن كيف عرفتَ ذلك..؟ فقلت له :
- لأنّ هذا ما كان يفعله سكّان مدينة قرطبة بالضبط في القرن الثاني عشر!".
ويضيف الكاتب الإسباني: "نعم إنّ الماضي جاثم وقائم وماثل وكائن هنا، إنّ المغاربة عندما يطلقون البارود في الهواء الطلق، فإنّما هم يقومون بنوع من العروض العسكرية التقليدية التي تصفها لنا المذكرات التاريخية القديمة العائدة للقرون الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر. إنّ المغرب أجمعه إنّما هو نقلة نحو الأمس، والتجوال في مدينة فاس أو مرّاكش على سبيل المثال هو نوع من الانبعاث عبر نفق الزّمن الغابر. كلّ شيء فيهما يبدو ساكناً، ثابتاً وراسخاً في الذاكرة والوجدان. وفي الواقع، والحاضر كذلك، إنّ المغرب هو المكان الوحيد في العالم الذي ليس فيه مجال لتكرار وتعاقب الصّور، وتوارد المعالم العمرانية والمآثر التاريخية، وتكرارها لتنوّعها وتعدّد مناظرها وثرائها فيه".
ويقول الكاتب: "إنّني إذا ما بنيتُ قصراً في المرتفعات والآكام الجبلية الإسبانية العالية، فإنّ ذلك سيكون مثيراً للسّخرية، إلاّ أنني إذا شيّدتُ منزلاً من هذا القبيل في مراكش- كما فعل بعضُ أصدقائي الإسبان، وغير الإسبان- فإنّ أحداً لن يضحك على محاولتي لإعادة استحضار الماضي البهيج، ذلك أنّ الماضي في هذه المدينة الجميلة بل في المغرب لم يمت. وهكذا فإنّ العمّال الذين سَتُسْندُ إليهم مهمّة بناء الدار لا ينحدرون فقط من أصل وجِذر هؤلاء العمّال الذين سبق لهم أن شيّدوا الدورَ، والقصورَ، والمنازلَ، والحدائق الغنّاء في قرطبة وغرناطة، بل إنهم سوف يقومون بهذا العمل المعماريّ بصبرٍ، وأناةٍ، وفنيّةٍ، وألمعيةٍ فائقةٍ، وحِرَفيّةٍ عليا، وبنفس مهارة أجدادهم الأقدمين .
(إنّ المسلم الذي يبني ….
مائة مثقال "دوبلاس"
كان يكسب في النّهار….
واليوم الذي كان لا يعمل فيه …
هو نفس القدْر الذي كان يخسره كذلك..)".
ويضيف الكاتب قائلاً: "بل إنّ المعمارييّن المغاربة سوف يستعملون المواد نفسها والأدوات التي اسْتُعملت في قرطبة وغرناطة، إنّهم سوف يعيدون اللّمسة والمهارة العريقتيْن القديمتيْن المتوارثتيْن سواء بالنسبة لهؤلاء الذين يشتغلون بالطّوب Adobe، أو بالطين أو بالفخار El barro، أو بالرّخام Marmol، أو بالفضّة Plata، أو بالذهب Oro أو بالخشب Madera".
عندما تتحوّل ساعة اليد إلى ساعة رمليّة
إذا كانت "ساحة جامع الفنا" الشّهيرة في مدينة مرّاكش قد أصبحت تراثاً إنسانياً عالميّاً اليوم، تحت رعاية منظّمة اليونسكو الدولية، فالفضل في ذلك كما هو معروف يعود للكاتب الإسباني المعروف الرّاحل خوان غويتيسولو، الحاصل على جائزة "سيرفانطيس" في الآداب الإسبانية، وعلى العديد من الجوائز الأدبية الأخرى داخل بلده إسبانيا وخارجها. هذا الكاتب الذائع الصّيت كان قد اختار - قيد حياته- هذه المدينة السّاحرة مكاناً أثيراً لإقامته، وعيشه وإبداعاته.
ويقول بلديُّه الكاتب "فرناندو ديّاث بلاخا"، كما قال العديد من الكتّاب العالميّين قبله منهم الكاتب البريطاني الشهير "وليام سُومرست مُوم" (25 يناير 1874 - 16 ديسمبر 1965): "إنه لكي نغوص في عمق التاريخ، ونجول في الماضي البعيد، ونتسربل بردائه، ينبغي لنا أن نقوم بإطلالة على السّاحة العمومية الكبرى في مرّاكش التي يطلق عليها سكّان هذه المدينة اسم "ساحة جامع الفنا"، فساعة يدنا في هذا المكان السّحري قد تتحوّل في رمشة عين، أو في لمحٍ من البصر إلى ساعة شمسية، أو مائية، أو رملية، إذ نشعر ونحن في خضمّها أنّنا قد عُدنا القهقرىَ مئات السنين.
إنّها السّاحة التي تُرْوىَ فيها قصائد "السّيد الكبيادور" و"لا ثيليستينا" و"كورباتشّو"، إنها ساحة شاسعة، واسعة، كاملة، ومتكاملة، وشاملة، إنها مازالت قائمة تماماً كما كانت موجودة من قبل.. عندما كان عنصر عدم الرّاحة غير متوفّر في الدّور والقصور وفي المساكن والمنازل، فإنّ هذه الأخيرة كانت تقذف بالناس منذ الصّباح الباكر إلى الشّارع، حيث تتجسّد الحياةُ اليومية النابضة، المتحرّكة، الدائمة، الدّائبة للمواطن العادي. هناك يمكنك أن تأكل، وتشرب، وتفاوض، وتناقش، وتغنّي، أو أن تلهو.. يجوبها الكبار من أجل المال وضمان قوت اليوم، ويرتادها الصّغار من أجل التسرية والتسلّي.
وفوق ذلك كلّه فإنك ترى أشياءَ مثيرة في أغرب عروض حلقية (نسبة إلى الحِلْقة) في العالم، حيث يغدو الشارعُ شبيهاً بسيرك كبير حيٍّ ومباشر مقسّم إلى أطراف، وأجزاء، إلى أناس يتجمهرون، زرافاتٍ ووحداناً في كلّ مكان، تتوفّر فيه جميع الأذواق التي تستجيب لكلّ الرّغبات والأهواء، وتُرضي كلَّ الأعمار والأجناس.
هناك تجد الرّجال البهلوانييّن، ومُروّضي الدّببة (كذا)، والقِرَدَة، والمّعز.. هناك يوجد الباعة المستقرّون والمتجوّلون، وهناك يوجد المشترون.. تتخلّلها تلك المناقشات و(الشطارة) اليومية، أو(المساومة) الدائمة التي لا تنتهي حول الأسعار التي تشكّل جزءاً مهمّا جدّاً من الحياة الاجتماعية اليومية للمواطن المغربي، وللسيّاح الأجانب الذين يتقاطرون بدون انقطاع على هذه الساحة العجيبة من كلّ صوْبٍ وحدب في زمننا الحاضر.
- حفظك الله يا رجل، كيف ترفض شراءَ شيء فقط لأنه قيل لك إنه باهظ الثمن..؟.
إنّكم سوف تهينون البائعَ حتى الموت، هذا الذي يساوم بدوره حتّى على كأس الشّاي، سبب وجوده وقوت عيشه اليومي..!".
أُذُنُ بشّار العَاشِقَة
إنّنا واجدون في هذه "السّاحة"علاوةً على ما سبق كذلك هؤلاء الذين يجمعون بين ماضي الأمس وحاضر اليوم. إنهم "الحلائقيّون" الذين يروُون أبهىَ القصص الخيالية، وينسجون أغربَ الحكايات الأسطورية تماماً كما كان يفعلُ أجدادُهم في القرون الوسطى في المغرب والأندلس على حدّس سواء.
إنّ الأغلبية السّاحقة من المستمعين، المتفرّجين والمتتبّعين المبهورين بهذه القصص والحكايات، مثل سابقيهم لا يعرفون القراءةَ ولا الكتابة، ولهذا فإنّهم يَسْعَوْنَ إلى إشباع رغبة فضول (الأذن) عندهم بما لا يستطيع المتفرّج أو المتتبّع الوصول إليه، أو الحصول عليه بواسطة (العيْن)، وقد أصاب شاعرُنا الكبير الضّرير- البصير بشّار بن برد كبدَ الحقيقة عندما قال: يا قوم أذني لبعضِ الحيّ عاشقةٌ / والأذنُ تعشقُ قبل العينِ أحيانا !.
إنهم هناك مشدوهون، مشدودون، مندهشون يقظون، ينظرون بعيونهم الجاحظة وقد كوّنوا حلقةً مستديرةً بإحكام حول الرّجل "الحاكي" أو "الحكواتي" الذي غالباً ما يكون طاعناً في السنّ، خَبَرَتْه الأيامُ وصروف الدهر، وحنّكته الليالي الحالكات، تراه نازلاً من أعالي جبال الأطلس الشامخة، أو نازحاً من صحارى القفار البعيدة، يسرد بوتيرة مسجوعة ومنغّمة رشيقة، وبكلمات منظومة مُفعمة رقيقة، ويحكي قصصاً مثيرة، وحكايات غريبة مُدهشة، وأساطيرَ مهولة تدور حول الغواني الحِسان، ذوات الحُسْن الباهر، والجمال الظاهر، وعن أميرات حسناوات صاحبات العفّة والصّون، وعن ربّات البيوت البواكي ذوات الدلال المَصون، ومثلما يحكي عن الأخيار، فإنه يحكي كذلك عن الأشرار الذين يرجّحون كفّة الشرّ على جانب الخير، وتراه يحكي بدون هوادة عن الفوارس المغاوير، والفرسان الشجعان الذين يرفعون عالياً ألويةَ الخير، ورايات النّبل، وبنودَ الكرامة الخالدة منذ الأزل، يحكي بفخرٍ وإباء عن هؤلاء القوم الذين لا توسّط بينهم، لهم الصّدرُ دون العالمين أو القبرُ..!.
تهون عليهم في المعالي نفوسهم، ومن يَخطب الحسناءَ منهم لم يُغلها المَهْرُ ..! إنهم بأسلوب التغنّي نفسه الذي طبع حكايات "السّيد" يجعلون المستمعين يعيشون في كلّ لحظة وحين الحدثَ التاريخي المَحْكيّ، أو الموقف المَرْويّ. أتذكرون…؟ "سوف ترونَ سِهَاماً، وترمقون نِبَالاً تصعد إلى الفضاء، وأخرى تهوي من السّماء" عندما يتمّ وصف المعركة، ونعود لشاعرنا المُجيد بشّار بن برد الصّادح في هذا المجال بأبلغَ بيتٍ قيل في الوص: (كأنّ مثارَ النّقع فوق رؤوسِنا / وأسيافِنا ليلٌ تَهَاوىَ كوَاكبُه) !..أو "آه لو حضر السّيد القمبيطور" أو عنترةُ بن شدّاد العبسي، أو سيف بن ذي يزَن.
هكذا يُقال عندما يكون الرّاوي يكاد أن يوشِك من الانتهاء من روايته المثيرة، أو حكايته - ومثلما كان يحدث في القرن الثاني عشر يمنحه المستمعون المتتبّعون - الذين يشكّلون حلقةً أو دائرة مُحكمة حوله - في الأخير بضعَ دُريهماتٍ، أو بالأحرى بضعَ (مرابطياتٍ) مثلما كان يحدث في الزمن الغابر ثمّ يعودون إلى دورهم في جُنح الليل ليحلموا بما سمعوا واستمتعوا، بينما يكون المتفرّجون الأجانب، نحن "المسيحييّن" الغربييّن وأمثالنا نعود إلى فنادقنا، وقد أرخى الليلُ سدوله وندلفُ إلى غرفنا في هدوء، لنعودَ ونسقطَ بعنف على سرير القرن الواحد والعشرين.!.
*كاتب وباحث ومترجم من المغرب، عضو الأكاديمية الإسبانية - الأمريكية للآداب والعلوم - بوغوطا- كولومبيا