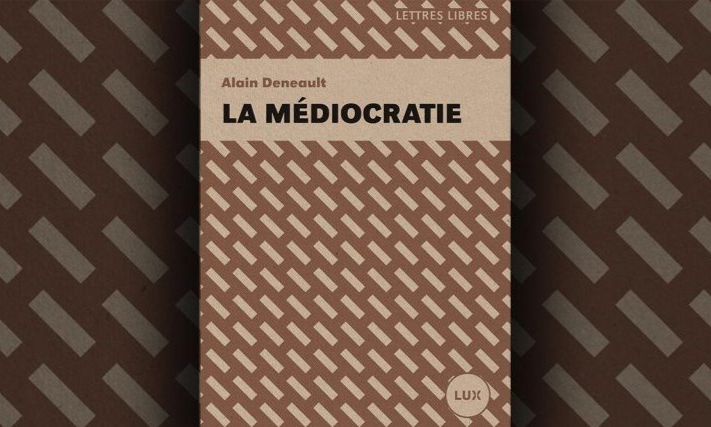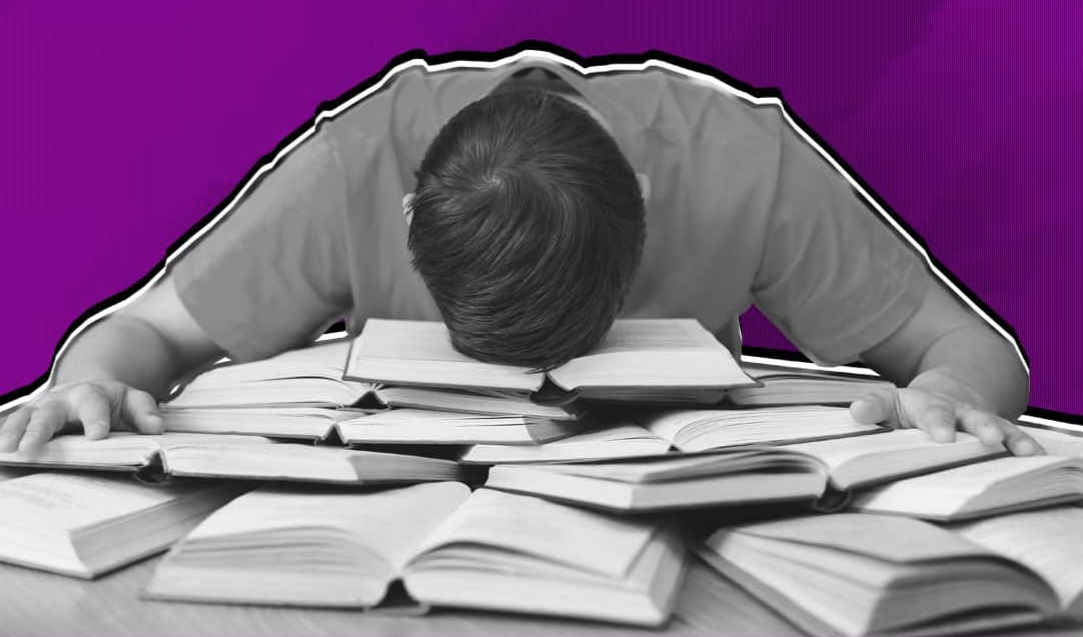إن الصدى الذي أثارته استخدامات مفهوم الإصلاح واستعمالاته المختلفة وحده كفيل بالتعبير عن استحالة الحديث عن حضور مضمون موحد من ورائه. وتختلف وظائف هذا التعبير النظري، باعتباره أداة تحليلية من داخل تاريخ الأفكار والعلوم الاجتماعية والنظرية السياسية، أو باعتباره مفهوما معياريا في البعد النقدي لهذه العلوم نفسها. فعودة المفهوم المتكررة وطرح نفسه في كل مرة كراهنية، منذ القرن السابع عشر في أوروبا، تعني في كل مرة شيئا مختلفا، لأنها تأتي في سياق متغير بنيويا وتاريخيا، ويولد في الآن حاجات جديدة، وأسئلة حديثة، يحاول المفهوم بين الفينة والأخرى الإجابة عنها. وإذا أضفنا إلى ذلك تطور النظرية وتراكم المعارف الإنسانية، فإننا سنجد بلا محالة أن دعوة المفهوم من غيابه التاريخي أو إحياءه يأتيان في كل فترة وحين في تقاطع محورين أساسيين ألا وهما: محور التطور التاريخي ومحور تاريخ النظرية ذاتها، ويشكل هذا التقاطع باستمرار سياقا جديدا، لتفسير وتأويل لمفهوم، وعلينا الا ننسى أن مفهوم الإصلاح هو نفسه جزء من السياق التاريخي بمحوريه، وهو بدوره يسهم في ذات السياق وفي تأويله. (1).
قبل الشروع في معالجة بعض القضايا والأفكار والميكانيزمات، التي حكمت ولادة ونشوء وتطور المفهوم "الإصلاح"، في السياق الأوروبي وفي علاقته بالمجال التداولي الإسلامي، أرى أنه من اللازم اللازب الوقوف لهنيهات عند بعض القضايا التي تهم المفهوم ذاته، فأقول إن المصطلح، أو ما يصطلح عليه، عادة ما يصاغ لتثبيت فكرة عن ظاهرة عينية، حيث يعكس ما هو ثابت في الصيرورة، وما هو عام في الجزئي. وبذلك ينقل الجزئي المتعين إلى مجرد (2)، أي إلى مصطلح يتوافر الحد الأدنى من الاتفاق شأن ما يعنيه.
كي يصبح المصطلح مفهوما يجب أن تكون له قدرة تفسيرية. وتختبر قدرته التفسيرية على الظواهر المختلفة في أنه في تجريده ما يدل على أنموذج نظري في فهم المتعين بشكل يمكن من إعادة إنتاج الظاهرة نظريا. ولهذا، فإن التوتر قائم في صيرورة مستمرة من المفردة إلى المصطلح بواسطة التجريد من الجزئيات، ثم من المصطلح المجرد إلى المصطلح العيني بواسطة إنتاج الظاهرة نظريا، آخذين بعين الاعتبار السياقات التاريخية وتطورها، لكن من دون محاكاتها نظريا. وتلك هي آلية النمذجة النظرية في العلوم الاجتماعية. يفترض أن يطور المفهوم من دون الوقوع في وهم أن تطويره من المصطلح المجرد إلى المفهوم (أي المجرد الركب العيني) هو تصوير للتطور التاريخي عينه، فهو ليس أكثر من نمذجة نظرية له، كما أن التوتر يبقى قائما بين التاريخ المفتوح من جهة، ومفهمة الأفكار بشكل نمطي، أي بناء مفاهيم ونماذج نظرية، من جهة أخرى، ولا سيما حين تتخطى المفاهيم والنماذج حدودها التفسيرية والتحليلية إلى الحدود المعيارية على صيرورة التاريخ. وهذا التوتر يكثف إشكالية العلاقة بين المفاهيم التاريخية المنمذجة والتاريخ باعتبارها صيرورة تتجاوزها (3).
ثمة عدد كبير من المفاهيم التي أقحمت إقحاما في مجالنا التداولي، هذه المفاهيم تندرج ضمن عملية من التشويه الاصطلاحي واللغوي وهي كما تبدو من خلال شحنها بدلالات ومعان إيديولوجية. من هذه المفاهيم، مفهوم الإصلاح، الذي يصف التحولات التي عرفها العالم الإسلامي أثناء وبعيد الهيمنة الأوروبية المباشرة وغير المباشرة. فهو - عنيت مفهوم الإصلاح- وهو بشكل أو بآخر يفصح عن مختلف المواقف السياسية والإيديولوجية، التي تنطوي على افتراض متأهل مفاده أن الحضارة الإسلامية ومقوماتها وعلى رأسها الشريعة بشكل عام، قاصرة ومحتاجة إلى تصحيح وتنقيح وتحديث(4).
فالمفهوم "الإصلاح" يستبطن تحولا، في أحد مستويين، من مرحلة ما قبل العصر الحديث إلى المرحلة الحديثة، وتحولا، في المستوى الآخر، من عدم التحضر إلى التحضر، وهو مؤطر بفكرة المركزية والتاريخانية الكونية التي يندمج فيها تاريخ الآخر في الأحداث الكبرى والمحددة للمسيرة الحضارية الأوروبية أي بمعنى آخر الكونية وتمثل الكونية، وهي ترجمة مفهومية أيضا، لما كان يطلق عليه يوما ما اسم الإمبريالية الأنطولوجية، باعتبارها أداة احتواء للآخر داخل الذات من خلال عدد من التعديلات التي ترمي دائما إلى تغيير ماهية الآخر (5).
وبذلك، يدل مفهوم "الإصلاح" دلالة معرفية على حكم غير قابل للاستئناف على تأريخ كامل وثقافة شرعية يراد تجنبها، بل محوها من الذاكرة والعالم الرمزي والمادي معا. فإذا ما غمرت دراسة الإصلاح على هذا النحو في هذه الترابطات الأيديولوجية، فعندئذ من الممكن القول إن مسار وبرنامج الإصلاح مقرر سلفا، وكل ما يحتاج إلى فعله سوى أن يبين كيف. الإصلاح الذي ألهمه الغرب من أجل إنقاذ الخاضعين لشرائع وثقافات ونظم معرفية للاستبداد الديني والسياسي، بكلمة استبداد الماضي، بهدف الأخذ بأيديهم في درب التحديث والحداثة والديمقراطية. فإذا نظر إلى الإصلاح على أنه أحدث المراحل عهدا في تاريخ الشريعة، أمكن القول عندئذ أن هذا التأريخ قد نسج ونظم وحبك في إطار حكاية أو سردية لا خيار لها سوى تقديم خاتمة مخصوصة، لمسرحية تعد مقدرة سلفا منذ البداية الأولى نفسها لتأريخها الذاتي. فلا يتحقق تناول موضوع الشريعة إلا بوصفها أثرا من آثار ماض ميت لا يُعرف له انتساب صحيح ولا استمرار في المكان والزمان، وإن التنظيم المعرفي للتأريخية من وجهة نظر "الإصلاح" يؤلف جزءا مكملا، وإن لم يكن الجزء الأهم، لحقل خطابي أوسع يواصل إنكار علاقته المعرفية والثقافية بالاستعمار، ومن ثم لا يندمج فيه (6).
ومن منظور آخر، بإمكاننا القول إن إيديولوجيا "الإصلاح" قد ناغمت أيضا الخطاب البحثي، مؤثرة فيه بطرائق أساسية، في البيئتين الأكاديميتين الغربية والإسلامية على حد سواء.
في هذا الإطار، أود أن أشارككم نصا لمشيل فوكو يبين بشكل واضح الآليات والميكانيزمات التي حكمت هذا الخطاب عنيت الخطاب الأكاديمي: "على المعرفة أن تصارع عالما بلا نظام، وبلا شكل، وبلا جمال، وبلا حكمة، وبلا انسجام، وبلا قانون، وهذا هو العالم الذي تتعامل المعرفة معه. وليس في المعرفة ما يمكنها، بمقتضى أي حق، من معرفة هذا العالم، وليس من الطبيعي للمعرفة أن تعرف. وبذلك، لا يجد المرء تواصلا بين الغرائز والمعرفة، بل يجد بدلا من ذلك علاقة صراع، وهيمنة، وعبودية، وتوطيد. فكذلك، لا يمكن أن تكون ثمة علاقة تواصل طبيعي بين المعرفة والأشياء التي على المعرفة أن تعرفها. وكل ما يمكن أن يوجد هو علاقة عنف، وهيمنة، وسلطة، وقوة، أي علاقة انتهاك، فالمعرفة أن تكون إدراكا أو تمييزا، أو تشخيصا، لهذه الأشياء أو معها" (7).
ولذلك، نجد لدى نيتشه الفكرة الدائمة التكرر التي مفادها أن المعرفة... تيسر، وتتجاوز الاختلافات، وتجمع الأشياء بعضها إلى بعض معا، بلا أي تسويغ في ما يتعلق بالحقيقة.
إن أكثر الحقائق مركزية وحسما في ما يتعلق بالحقل الأكاديمي هي أنه – شأنه شأن كثير من الحقول المهيمنة على البيئة الأكاديمية في أيامنا هذه- قد ولد في نطاق المغامرات العنيفة لأوروبا في القرن التاسع عشر ومن رحمها، وهي مع ذلك مغامرات ساعية إلى المجانسة بقوة. وقد ولد في سياق مشروع عالمي للهيمنة. فالنص المقتبس آنفا لا يشير إلا إلى البنى المعرفية للسلطات السياسية والاقتصادية والثقافية، التي في كنفها تطورت قضايا ماضي وحاضر ومستقبل المسلمين، نشأـ وترعرعت بوصفها حقلا بحثيا، ويمكن أن يعبر عن ذلك بالضد فيقال إنه ما كان ليكون بناء التأريخ الإسلامي حديثا، بمعزل عن المعايير الخطابية لأوروبا في القرن التاسع عشر، وخارج عنها، ضمن رحم بلا نظام، وبلا ترابط وبلا شكل، اخترعت أوروبا المعرفة التي هي الثقافة الإسلامية الحديثة.(8).
ولم تظهر خطابات السلطة التي شكلت هذا الحقل المخترع، بمظهر الكيان الموحد البتة، بل كانت اختلافا كبيرا أو متناقضة تناقضا داخليا في أغلب الأحيان. وقد نافحت هذه الخطابات عن مصالح استعمارية مخصوصة، وتصورت في الوقت نفسه الثقافات والمجتمعات الإسلامية بطرائق مختلفة اختلافا مثيرا. وأنتجت تواريخ للعلم وجغرافيات، ومقاربات لدراسة العالم الإسلامي كثيرة كثرة ما بوسع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية أن تحشده؛ بيد أن خطابات السلطة، على الرغم من تنوع توجهاتها، كانت في الوقت نفسه أحادية الوضوح واتخذت مسارا يسعى إلى خدمة مجموعة تتشاطر أهدافا متكاملة ومتماسكة على نحو تبادلي. هذه الخطابات التي تلح على مسألة ضرورة نظر الشعوب العربية والإسلامية وفهم تاريخها المحلي في إطار الماضي الأوروبي، لأن هذا الماضي هو الذي وضع التاريخ الشامل من خلاله.
ويرى هذا التاريخ أن تأريخ الشعوب غير الغربية تاريخ "محلي"، أي تاريخ ذو حدود، وقد عومل تاريخها المعاصر وفق هذا النهج أو النحو بالضبط؛ فالغربيون ينظرون إلى تقاليد الأمم غير الغربية من وجهة نظر التنوير الأوروبي في العادة، وهي نظرة تنحو إلى تقييم التقاليد بحسب قربها من التنوير والنموذج الليبيرالي أو بعدها منه.(9).
فلا تزال حدة العلاقة بين المعرفة والسلطة صعبة السبر، بيد أنه لا توجد ظاهرة يمكن فهمها حق الفهم إذا كانت هي كل ما يعرفه المرء. فلا يمكنني أبدا فهم ما تعنيه الرحمة وتثيره من أحاسيس إذا لم تكن لي أي خبرة بقسوة المشاعر، ولا يمكنني قطعا إدراك المعنى الفعلي للارتواء إذا لم أشعر بالعطش الحقيقي. فالمقابلة – وليس المقارنة فحسب- هي أداة معرفية ذات كفاءة مدهشة. فمن دون المقابلة يمكن للمرء أن يقضي عمره في دراسة مجال الواقع الذي يبرز التداخل بين المعرفة والقوة دون أن يفهم قوتها الكاملة أبدا، ناهيك عن بنيتها واستثنائيتها وتفردها ونسبها. إن هذا الغياب للمنظور والمقابلة والمقارنة حمل منهك للفهم؛ فحتى حين حلل فوكو بحيويته جمة نشأة الظواهر الأوربية (كالقوة والمعرفة والمراقبة وما إلى ذلك) كان إطاره المقارن يقع في السياقات الأوروبية السابقة التي تتجلى آثارها الصاعقة والمخيفة مثلا في تحولات أشكال العنف والعقوبة والتعذيب.
يسمح هذا الغياب المنظور والآثار المصاحبة له بتعميم كوني سهل للظواهر، تعميم يسقط هذه الظواهر على التاريخ كله، أوروبيا كان أو غير أوروبي، حداثيا أو غير حداثي. وبما أن مشكلة أغلب التخصصات الأكاديمية هي موقعها في تلك العلاقة، فمن الضروري أن نسأل عن ذلك الشيء الذي يجعل التلازم العضوي بين القوة والمعرفة ممكنا في المقام الأول.(10).
من هنا، فإن نموذج الدولة الإسلامية توصف بأنها دول ذات نظام استبدادي لا تعرف النقد، من هنا يمكن أن نفهم كيف ظل ميل الشريعة الأخلاقي شوكة في جنب الاستعمار، شوكة يتعين نزعها. هكذا، يلخص القضاء على الشريعة في القرن التاسع كل شيء، لم تستطع الحداثة ودولتها أن تقبلا، ولا يمكن لهما أن تقبلا، الشريعة بمعاييرها؛ لأن هذه المعايير أخلاقية وذات نزعة مساواتية بصورة عميقة، بينما أنزلت الدولة الأخلاق منزلة النطاق الثانوي، باختصار شديد، كان النطاق المركزي للاستعمار هو الاقتصادي والسياسي وليس الأخلاقي، الذي اعتنت به الشريعة أيما اهتمام وجعلته في قمة اهتماماتها. كما يظل الاقتصادي والسياسي هو النطاق المركزي للحداثة اليوم ولعولمتها المتزايدة؛ غير أن الشريعة تبقى اليوم، على الرغم من آثار الاستعمار المدمرة، محل النطاق المركزي للأخلاقي، فبينما تقادمت كثير من مؤسساتها وتفسيراتها وشخوصها وتلاشت واندثرت لا تزال آثارها الأخلاقية صامدة بإصرار لا يتزعزع. ويمكن لهذا النظام الأخلاقي، وهو رأس مال لا يقدر بثمن، أن يدعم ويدفع بعجلة التغيير ومن ثم الاستئناف الحضاري الذي ننشده. (11).
بكلمة، إن هذا الأمر ينطبق عل كل المفاهيم والمؤسسات الكبرى التي تحكم العالم الإسلامي اليوم. في المقابل قدمت النطاقات المركزية للإسلام ما قبل القرن التاسع عشر نماذج راسخة لهذه المقابلات، وقد دمرت الكولونيالية هذه النطاقات تحديدا؛ لأنها وقفت على النقيض من أهداف نطاقات أوروبا المركزية. لقد أخذ مؤرخو أوروبا في القرنين السابع والثامن عشر يذكرون كيف أن تشكيل الدولة الحديثة تطلب الإعادة القسرية لتعريف الدين بأنه الإيمان، وبجعل أمور الدين والعواطف والهوية الدينية أمورا شخصية تنتمي إلى فضاء الحياة الشخصية الآخذ بالظهور، في مقابل بروز فضاء عام وحياة عامة تحكمها روابط وشروط وضوابط مغايرة.
لقد أثبتت اضطرابات حركة الإصلاح من وجهة نظر أولئك الذين رغبوا في إيجاد دولة مركزية قوية، وأن الإيمان الديني كان مصدرا للعواطف التي تصعب السيطرة عليها داخل الفرد. ولهذا السبب، فإن هذا الإيمان لا يمكنه أن يكون أساسا مؤسسا لأخلاق عامة، ولا لإيجاد لغة عامة للنقد العقلاني(12).
لهذا، لم يتهيب هوبز مثلا من القول إن الدين مؤسسة تخدم مصلحة فئة من الناس، وأنه يجب لذلك أن يخضع للقيصر، نلحظ لدى حديثنا عن كانط كيف تحول الدين للحياة الخاصة، قوامه الألفة الاجتماعية، يحل محل دين للعامة قوامه الاعتقاد المشوب بالعاطفة. وقد غدا من نافلة القول بين مؤرخي أوروبا الحديثة إن الدين اضطر للتخلي عن حقل القوة العامة للدولة الدستورية، وعن الحقيقة العامة للعلوم الطبيعية، ولكن ربما كان بإمكاننا أن نقول أيضا إننا في هذه الفترة نحصل على الدين وقد تحول إلى شيء جديد تحكمه ظروف تاريخية محددة: شيء ينبع من التحررية الشخصية، ويمكن التعبير عنه بعبارات اعتقادية، ويعتمد على المؤسسات الخاصة، وتجري ممارسته في وقت الفراغ. وهذا التصور للدين يضمن حصره في جزء مما هو غير أساسي لأنشطتنا السياسية والاقتصادية والعلمية والأخلاقية المشتركة(13).
وفي هذا الإطار، يقرر غوشيه أن الدين المتقلب في أطوار، ولو أنه استطاع أن يستقل بتنظيم المجتمع كله، فإن مؤسساته لا بد أن يكون مآل دورها الاجتماعي هو الزوال، وهذا القول يكذبه تزايد الحاجة إلى الدين في الوقت الحاضر، ولم يسع غوشيه إلا أن يقر بهذا الرجوع ولو أنه ينكر أن يعيد تشكيل الفضاء المجتمعي خارج نطاق الحداثة وعلى نسق النمط الديني القديم، من المنطقي أن الدين إذا عاد لا يمكن أن يعيد صوغ المجتمع خارج الظروف التي عاد فيها؛ لكن هذه الإعادة لا تعني بالضرورة، كما يظن بعضهم، أنها صياغة تسطح التدين، فلا ترقى إلى تدين المتقدمين، بل يحتمل أن تكون صياغة تعمق التدين حتى منافسة تدين المتقدمين، فلم لا يجوز أن يكون العمل الروحي محكوما بقانون التراكم، كما يحكم تطور العمل العلمي، بحيث تتزايد المعرفة بأسراره كما تتزايد المعرفة بقوانين العلم.
فإذا سلمنا بمبدإ التراكم هذا، فلا يبعد أن يكون ما يدرك من المعاني الروحية في كل طور من أطوار الإنسانية يتسع لأكثر مما أدرك في الطور الذي سبقه، فيكون مستقبل التدين أفضل من ماضيه، إلا أن يكون العالم الروحي يخضع، هو الآخر، لما يخضع له العالم المادي من دورات حضارية تبدأ بالصعود، ثم تبلغ ذروتها، ثم تأخذ في النزول.(14).
أختم الكلام عن الدين والفضاء العام، بفيلسوف حديث ألا وهو هابرماس، الذي أكد في كتاباته المتأخرة على ضرورة تطوير موقف ما بعد علماني يأخذ في الاعتبار حيوية الدين في المجتمعات المختلفة، ولا يهمل إنجازاته المتراكمة على مستوى الهوية والأخلاق معا. إن وجهة النظر الدينية وحيويتها قد تساهمان في مواجهة مخاطر عدة مثل الرأسمالية المعولمة، وتذر الأفراد بحثا عن مصالحهم الفردية وغيرها؛ لكن كي تدخل مثل هذه الإنجازات على الفكر الديني في المجال العام لا بد من ترجمتها إلى لغة عقلانية متاحة للجميع، المتدين والعلماني معا، ممن يتشاركون في الاستخدام العمومي للعقل كما في نظرية الفعل التواصلي. والمجال العام عند هابرماس هو مضمار للجدال العقلاني النقدي. والسماح بدخوله مسألة قدرة ورغبة في المشاركة في مجال مفتوح، أما الأفكار الدينية فمتاحة لأصحابها من تقليد محدد فقط، وبالتالي لا بد من ترجمتها إلى لغة العقل العام. المشكلة هي أن هذه الأمور قد تكون دعوة إلى الاحتواء، والمشكلة الثانية هي أن ترجمة الأفكار مسألة غير متكافئة، وكجواب عن هذا الإشكال يقارب تيلور مسألة الدين في المجال العام عبر المعاني المتنافسة للعلمانية مؤكدا الأخوة التي تتضمن الاحترام المتبادل والتسامح.(15).
يرى بعض الباحثين أن التسامح الديني كان وسيلة سياسية لتشكيل الدولة القوية، التي انبثقت عن الحروب الطائفية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، ولم يكن منحة خالصة قصد منها الدفاع عن التعددية. كان من رأي لبيسيوس الكاتب المتشكك في مجال الدين، الذي كان له تأثير كبير في أواخر القرن السادس عشر، أن على الأمير أن ينتهج أي سياسة تضمن السلم الأهلي بغض النظر عن التحفظات الأخلاقية او القانونية، وإن بإمكان إزالة التعددية الدينية بالقوة، فذلك قد يكون خير وأبقى، أما إذا استحال ذلك فإن على الدولة أن تجبر الناس على التسامح، وكان الدافع وراء موقف جون لوك الشهير من التسامح الديني بعد قرن من الزمان، هو الحرص على وحدة الدولة وقوتها، فقد عارض التسامح مع الكاثوليك والملحدين لأنه اعتقد أن معتقداتهم، تشكل خطرا جامحا على السلم المدني الداخلي.(16).
في الوقت الحاضر تتخذ الدولة الحديثة (العلمانية)، بناء على التصويت أو انطلاقا من تقديراتها الخاصة، قرارات محددة أو قوانين مسطرة تضبط بها أو تراقب جوانب من حياة الأفراد، ساحبة لها من الدائرة الخاصة التي كانت تعد جزءا منها إلى الدائرة العامة، وهذا يعني أنها قرارات أو قوانين تقوم بما سماه الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن بـ"عوممة" الحياة الشخصية. فيردف قائلا وحسبك شاهدا على هذه العوممة القوانين الفرنسية المتعلقة بمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والأمكنة العمومية، فالدولة، بحسب طه عبد الرحمنـ في هذه الحالة ترتكب مخالفتين: أولاهما مخالفة مبدإ اختيار الاتجاه الوجودي، بحيث أن الدولة تسعى إلى مواعدة مواطنيها، بأن لهم الحرية المطلقة في اختيار معتقداتهم وأن حرية العقيدة والتدين أمر كفله الدستور، حتى أنهم إذا أرادوا مشاركتها إصلاح تدبيرها، عن طريق استنزال المعاني الغيبية لمعتقدهم، لم تتردد هذه الأخيرة بنقض العهد والانقلاب عليهم. أما المخالفة الثانية فهي ما يسميه: مخالفة مبدإ المنهج التدبيري، حيث إن الدولة تلزم مواطنيها بتدبير معتقداتهم بما يضاد التدبير الذي يرتضونه لأنفسهم، وبهذه الممارسة تكون الدولة قد أتت أشد أنواع العنف، وفتحت الباب على مصراعيه، لممارسة العنف الروحي وهو أشد من العنف النفسي وهذا بدوره أشد من العنف البدني، بينما يظل عنفهم هم، لو فرضنا وجوده، عنفا نفسيا، لأنه عنف سياسي، ما دام أن السياسي هي الصفة التي تناسب دائرة العام.(17).
الهوامش:
1 وائل حلاق، الشريعة النظرية، والممارسة، والتحولات، ترجمة كيان أحمد حازم يحيى، دار المدار الإسلامي، ط الأولى، 2018
2 عزمي بشارة، المجتمع المدني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط الأولى، 2016
3 عزمي بشارة، مصدر سابق
4 وائل حلاق، الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة عثمان عمرو، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط الرابعة، 2016
5 وائل حلاق، مصدر سابق
6 وائل حلاق، مصدر سابق
7 وائل حلاق، مصدر سابق
8 وائل حلاق مصدر سابق
9 وائل حلاق مصدر سابق
10 وائل حلاق، قصور الاستشراق، ترجمة عمرو عثمان، صفحة 45 – 46
11وائل حلاق، الدولة المستحيلة، ترجمة عمرو عثمان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طبعة 2016
12 عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الجزء الأول، المركز العربي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط الأولى، 2013
13 عزمي بشارة، مصدر سابق
14طه عبد الرحمن، روح الدين، المركز الثقافي العربي، ط الأولى، 2012 صفحة 187 - 188.
15عزمي بشارة، مصدر سابق
16عزمي بشارة، مصدر سابق
17 طه عبد الرحمن، مصدر سابق