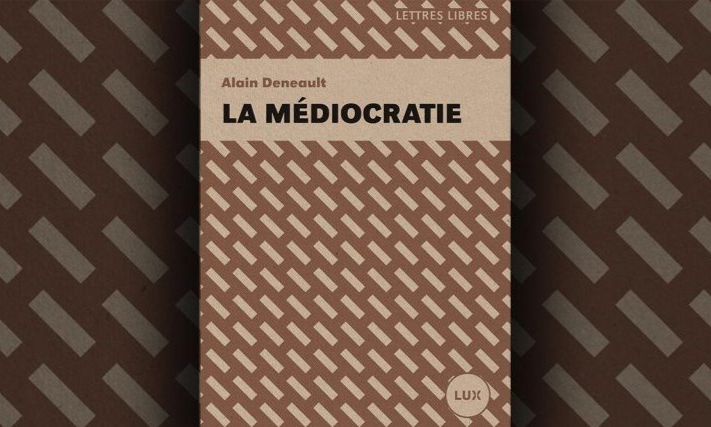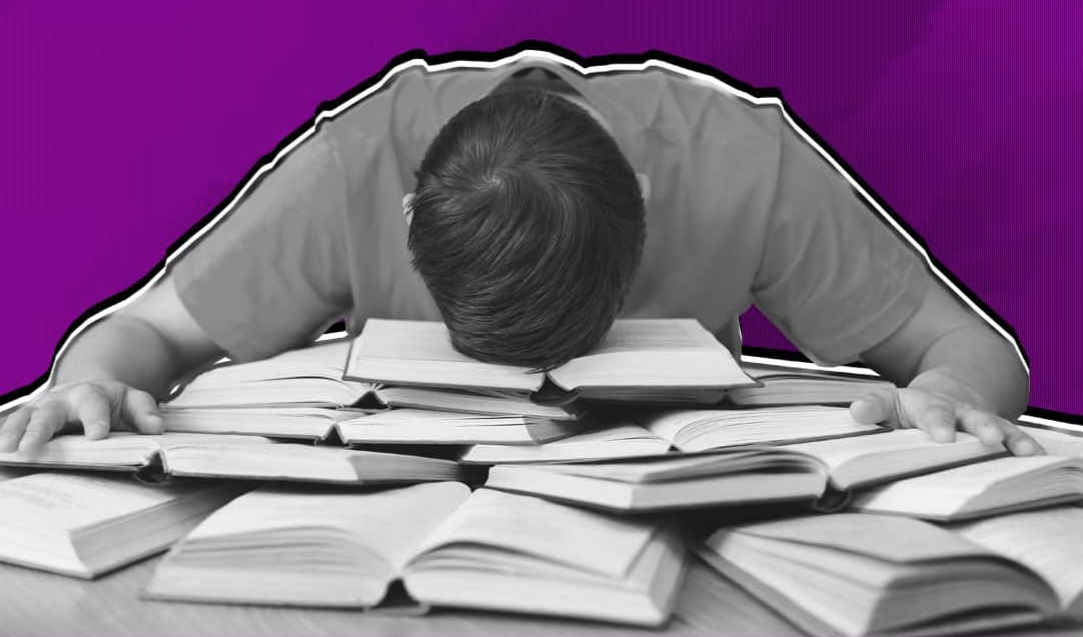في أسبوع واحد اهتز الرأي العام المغربي على وقع حدثين مدويين يلتقيان على قاسم مشترك هو أمن المغرب والمغاربة، وإن كانت المقاربات بين هذين الحدثين نوعا ما متفاوتة. الحدث الأول كان بلسما وموضع اعتزاز وافتخار وهو حينما أفلحت مؤخرا أجهزة المخابرات المغربية في تفكيك خلية إرهابية بعد أن ألقت القبض على عناصرها الذين كانوا يخططون لضرب أمن واستقرار البلاد في العمق. والحدث الثاني الذي غطى عن الحدث الأول وأفسد على المغاربة فرحتهم هو اختطاف الطفل عدنان الذي اغتصب وقتل لتغتصب وتقتل معه الطفولة المغربية. لماذا أرادت سخرية القدر أن تفتح أعيننا على هذين المشهدين المرعبين؟ وما هي دلالات ذلك والعبر التي يمكن استخلاصها لمعالجة هذه الآفة؟
1 ـ لا أحد منا يمكن أن يجادل في يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، وعلى وجه التحديد تلك العين الساهرة لأجهزة المخابرات. نحن ننام ملء جفوننا وفي أفرشتنا الدافئة، ورجالها يقضون لياليهم في العراء تحت وطأة الحر ولسعة البرد. يواصلون الليل بالنهار، ويلاحقون في الخفاء كل إرهابي في المدن والمداشر، ويتقمصون أدوارا ما أنزل الله بها من سلطان ما بين ماسحي الأحذية ورعاة الغنم والبقر أو التظاهر بالجنون أو "تهداويت". كل هذا التعب وهذه المعاناة ليصلوا، ونحن عامة الدهماء في غفلة من أمرنا، إلى الأيادي التي تريد أن تمتد إلينا وتعبث بأمن واستقرار بلادنا. وباحترافية قل نظيرها في العالم، تجد هؤلاء الرجال في صراع مع الزمن يستبقون الجريمة ويحولون دون وقوعها في لحظة حاسمة بعد أن تجمعت لديهم كل المعطيات عن الشبكة الإرهابية وعن عناصرها وعن مواقع تواجدهم في أكثر من مكان. والملفت للانتباه أن العملية الأخيرة التي انتهت بإلقاء القبض على عناصر الشبكة في كل من تمارة وطنجة وفي ضواحي مدينة تيفلت بمحاذاة شط غابة معمورة، تمت هذه في غاية الدقة، أي في توقيت واحد بالدقيقة والثانية، مما يظهر القدرة الفائقة على التنسيق في الاقتحام لمختلف الأماكن التي يتواجد بها الإرهابيون من دون تمكين ولا واحد منهم من الإفلات.
المقاربة الأمنية لأجهزة المخابرات المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تعد مفخرة لكل المغاربة، بل أكثر من ذلك فمفعولها وصداها تجاوز الحدود الوطنية، وباتت أنشطتها موضع اهتمام من طرف العديد من أجهزة المخابرات العالمية، وفي مقدمتها أجهزة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية. وليس من باب الصدفة أن يقلد رؤساء المخابرات المغربية بحمالات كبرى لبعض الدول اعترافا بالجهود الدولية التي يبذلها المغرب في مكافحة الإرهاب. ولقد كان لبلادنا دور بارز في الوصول إلى تحديد هويات بعض الإرهابيين الذين كانوا وراء أحداث العاصمة الفرنسية باريس عام 2016 والعاصمة البلجيكية بروكسيل.
لكن أين يكمن سر هذا الإنجاز الكبير؟ فبقدر ما هو إنجاز وطني فهو إنجاز جماعي تحركه وطنية صادقة على جميع المستويات وتعبئة شاملة غير مرئية تساهم فيها فئات من المجتمع المغربي كـ"المقدمين" والشيوخ وكحراس الليل في مواقف السيارات وحراس العمارات ورعاة الأغنام والأبقار في الغابات وفي المناطق النائية. كل هذه الفئات تشكل النواة الأولى في الاستعلامات وفي بناء المعلومة بشكل تدريجي إلى حين الوصول إلى مرحلة التتبع والرصد حينما تتزايد احتمالات الشبهة. وعند الانتقال من مرحلة الشك إلى اليقين يصبح دور الأجهزة الوطنية ملحا ووحيدا وتنتهي على إثر ذلك كل أدوار المتدخلين السابقين ويبقى دور الفرقة الوطنية هو الناهي وهو الآمر.
2 ـ وعلى النقيض من ذلك، قد نجد نوعا من الترهل في المنظومة الأمنية المتصلة بالحياة اليومية لعامة المغاربة؛ إذ تفتقر هذه المنظومة في بعض الأحيان إلى تلك اليقظة التي تتحلى بها المخابرات المغربية في مجال مكافحة الإرهاب. ومرد ذلك إلى كون تلك اليقظة نستحضرها بقوة عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة وبمؤسساتها وبكل ما يمكن أن يهز كيان المغرب كدولة وإن كان ذلك في الوقت نفسه يخص أمن واستقرار المغاربة بالتبعية. لكن تلك اليقظة مطلوبة أيضا ويجب أن نلمسها في الحوادث اليومية التي تهز الأحياء والشوارع المغربية من قبيل التحرش والاعتداءات والسرقات والاختطافات التي كثيرا ما تفضي إلى عمليات الاغتصاب كما حدث من قبل وكما حدث مع فاجعة الطفل عدنان وما قد يحدث من بعدها بكل تأكيد. والمسؤولية على مستوى منع الجريمة هي مسؤولية مزدوجة ما بين رجل الأمن وما بين المواطن.
وإذا كان الحدث الأول يشهد عن عمل المخابرات بكونه عملا استباقيا يحول دون وقوع الجريمة، فإن النشاط اليومي للأجهزة العادية غالبا ما يتم إلا بعد وقوع الجريمة، وهو وضع غير طبيعي لأن الأصل هو منع الجريمة قبل ملاحقة مرتكبها. وكذلك المواطن يعاب عنه تفرجه على الحدث في مسرح الجريمة أو أحيانا تصوير المشهد المروع وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما المطلوب منه في تلك اللحظة التدخل بالشكل الذي لا يعرضه للخطر من أجل منع الجريمة أو الإسراع على الأقل إلى التبليغ عن مرتكبها كما تنص على ذلك القوانين.
كثيرة هي الأعطاب التي تنخر مجتمعنا، ولعل فاجعة عدنان من أكثر المشاهد ترويعا ومثلها كثير مسكوت عنه. وبالفعل فإن حالة التذمر التي تركتها هذه الفاجعة في النفوس لدى الرأي العام المغربي تستوجب الوقوف عندها. ويمكن أن نتفهم ذلك التضامن العريض مع عائلة عدنان لأن هذا الطفل البريء هو ابن لجميع المغاربة وما حصل له يمكن أن يحصل لكل أبنائنا. ويمكن كذلك أن نتفهم تلك النداءات التي تطالب بأقصى العقوبات في حق الجاني إلى حدود إنزال عقوبة الإعدام عليه. لكن هذه النداءات أثارت ردود فعل متباينة ما بين مؤيد وما بين معارض. سند المعارضين في ذلك هو أن المغرب مرتبط باتفاقيات دولية وقع عليها والتزم بها، تقضي بإلغاء أو عدم تطبيق عقوبة الإعدام. وقد وضع المغرب قطيعة مع هذه العقوبة منذ عام 1993 بإعدام الكوميسير الحاج ثابت. لكن المحاكم المغربية أصدرت في أوقات لاحقة أحكاما بالإعدام دون أن تعرف طريقها إلى التنفيذ.
بل أكثر من ذلك، يقول العلمانيون، وهم في ذلك يعارضون التيار الإسلاموي، إذا السارق تقطع يده والزاني يرجم إلى حد الموت والقاتل يقتل، فسنجد أنفسنا أمام مجتمع نصفه عاهات ونصفه الثاني من مرضى نفسانيين. ولذلك يرى هؤلاء العلمانيون أن الحل لا يكمن في الإعدام بل في مراجعة شمولية لسير المنظومة الأمنية من خلال تغيير آلياتها، بما فيها العقليات السائدة، وكذلك من خلال مراجعة حقيقية للمنظومة التربوية في مناهجها ومقرراتها لخلق جيل متوازن بعيدا عن التزمت ولكي لا تهيمن عليه هواجس الجنس وفي أبشع تجلياته زنى المحارم الذي لا يسلم منه المجتمع المغربي رغم التستر عنه خشية الإساءة إلى السمعة والكرامة. ويجب على الخطاب داخل العائلة أن يكون خطابا منفتحا على التواصل وكسر الطابوهات أو المحرمات في النقشات الأسرية من قبيل "حشومة" وغيرها من أدوات القمع التي تستعمل ضد الطفل عن غير وعي أو قصد. الحوار داخل العائلة لا يمكن له إلا أن يبني شخصية متوازنة للطفل وتمكينه من الاستقلالية في مواجهة أوضاع مشبوهة خارج البيت. ومن جهة أخرى، تبقى السلامة العقلية والأعطاب النفسية واحدة من المرتكزات التي يجب إدراجها في دائرة الاهتمام بالطب النفسي في مجال محاربة الجريمة، وقد يساعد ذلك القاضي أو المحقق أو رجل السلطة على أداء الواجب، وعلى معالجة المشكل من الأساس.
وعن النقاش الوطني الدائر حاليا بسبب فاجعة عدنان ما بين المؤيدين لتنفيذ عقوبة الإعدام وما بين المعارضين لها، شخصيا أعتقد أن المقاربة في هكذا حالات لا وجود لما هو أبشع منها وأكثرها قرفا، يجب التعاطي معها من منظور كلي وشامل من دون أي استثناء. فتنزيل عقوبة الإعدام وأمام الملأ ضروري كأداة للردع، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن ينسينا ذلك معالجة هذه الظاهرة المقرفة بالأساليب العلمية والحضارية على مستوى العائلة وعلى مستوى المدرسة وعلى مستوى قيم التمدن في المجتمع، وأخيرا على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها.