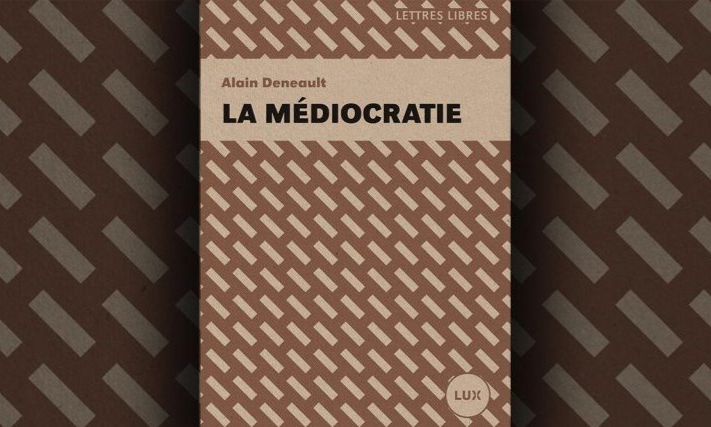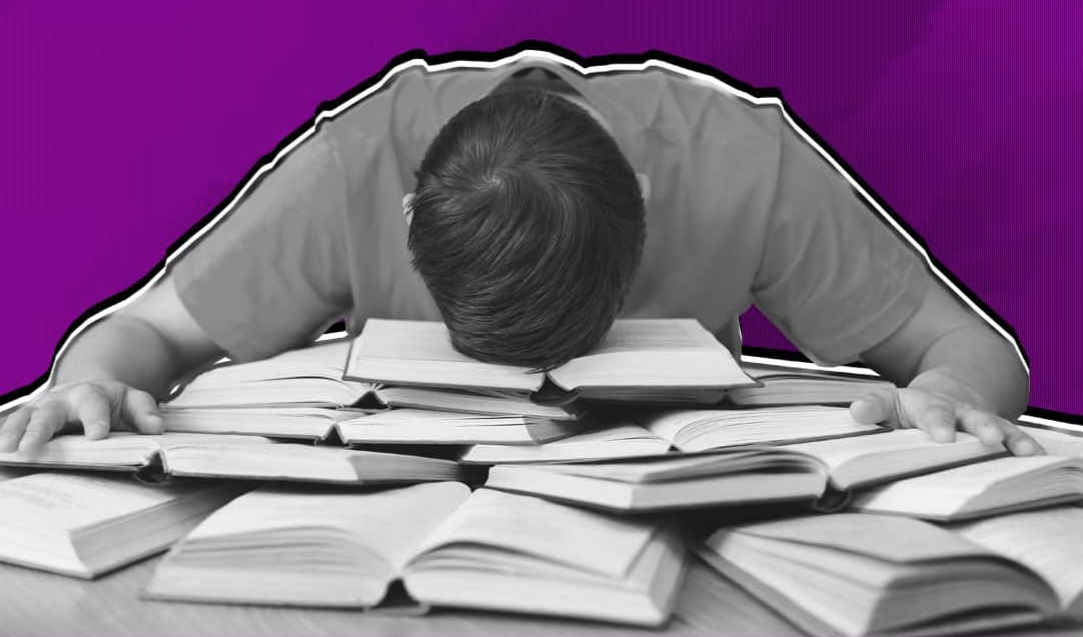قبيل نهاية الإجازات يصاب العمال بنوبات اكتئاب حادة؛ ففي اليوم الأخير لا يفكر العامل سوى في الغد. في الاستيقاظ الباكر، في التنقل، في ابتسامات المدراء والزملاء المزيفة، في الروتين السيزيفي للثواني والدقائق، في برنامج بعد العمل، في الصراع بين الرغبة في السهر والنوم المبكر. هي حلقات تتكرر طيلة حياة العمال، تلازم روحهم، وتشغل أحاديث مقاهيهم، وحتى من يحاول الانعتاق من شكوى العمل وروتينه يتحدث عن مبالغة الزملاء في الشكوى من العمل.
الشكوى دين “العمال”، لكن لماذا لا يحب أحد عمله؟ الإجابات متعددة بطبيعة الحال، ومختلفة من فئة إلى أخرى، من طبقة أجور إلى أخرى؛ ففي النهاية العمال طبقات أجور فقط. فالأدنى منهم هو من يستشعر سعادة الأعلى دون أن يشعر بها المعني بالأمر. يسرح خيال الأدنى في الامتيازات التي يحظى بها أصحاب الأجر الأعلى، يتخيل كيف يقضون عطلهم وإجازاتهم الأسبوعية. وكل ما يتخيل ضرب خيال لأن الأعلى مشغول في تخيل حياة الأعلى منه وهكذا دواليك.
السبب الأول مادي بطبيعة الحال؛ مادي من الناحية المالية، فالأجر مهما كان مرتفعا يبقى أجرا محدودا، وكلما زاد الأجر زادت الطموحات ومتطلبات الحياة. فالعمل بالأجر لا يمكن أن يحقق السكينة والاستقرار إلا للذين ينظرون من الخارج؛ أولئك الذين لا أجر لهم. ومادي من ناحية روتينية العمل القسري. نعم العمل قسري؛ فقلة قليلة فقط من يشتغلون في مجالات تشكل موضوع رغباتهم وطموحهم وشغفهم، بل من مِن العمال يعرف طموحه وشغفه؟ من أين له الوقت في التفكير في ذلك؟
أما السبب الثاني فنفسي، وهو نتيجة حتمية لأسباب ترتبط بالنشأة الاجتماعية التي تعتبر من يحصل على المال دون جهد محظوظا، ومن يماطل في عمله دون أن يكشف فائق الذكاء، ومن له عمل رسمي دون خوف من الطرد وتقلبات الاقتصاد “مرضي الوالدين”، وهو ما يفسر رغبة الجميع في التوظيف، وبطبيعة الحال فالخوف ليس نابعا من الذات فقط، بل مرتبطا أيضا بطبيعة أنظمة التشغيل في الدول المتخلفة، فالمتعاقد مطرود مع وقف التنفيذ في العرف النفسي الاجتماعي. وحين يحصل الشخص على عمل وظيفي، ينظر إلى من اختار المغامرة ونجح في خط مسار مهني وحياتي ناجح، فيتحسر على السنوات التي قضاها في عمل روتيني يومي دون تقدم مالي ملحوظ، فيلعن نفسه ويلعن عمله، ويقرر تعلم لغات جديدة، ومهارات أخرى لينفتح على العمل الحر، لكن دون أن يترك صمام أمانه: وظيفته، يريد المغامرة من داخل الأمان. لكن ما أن تطلع الشمس حتى ينهض كروبوت إلى عمله، فينسى تخطيط الليل، وينغمس في روتين اليوم، وحين يعود إلى منزله يقرر النوم والراحة بعد يوم شاق، ليلعن نفسه على تراخيه في تعلم اللغات، والمهارات الجديدة، ليعاود التخطيط من جديد وهكذا دواليك… إن العمل الروتيني يكلس العقل، يعلم التراخي لأنه آمن، وواضحة نهايته، فيكون بذلك العامل الذي وصل سن التقاعد قد حاز خبرة سنة متكررة عشرات السنين فقط. فلنكن صرحاء مع أنفسنا؛ قلة قليلة منا من تملك مخططا لحياتها؛ مخطط السفريات والرحلات، مخطط الإجازات القصيرة والطويلة، بعبارة أخرى قلة منا من يملك نمط حياة مريح. فالعامل الشاكي يسرح خياله في الأشياء التي سيحققها لو نجح ماليا؛ وهي أشياء يحلم بها الطفل صغيرا كامتلاك سيارة، ومنزل فاخر، والسفر أينما شاء… لا تختلف أحلامهم عن أحلام الأطفال إلا في الحسرة التي يشعر بها العامل لأنه لا يملك مالا يجعله سعيدا.
إن الحياة سلسلة مطالب ورغبات، وهي قبل كل شيء سلسلة أحلام، وهي ليست متأتية إلا لمن يعطي قيمة للوقت، من يمتع نفسه وهو يسعى إلى التقدم والتطور (ماليا أو اجتماعيا أو علائقيا…)؛ فلا يجب أن ننسى أن الحياة قد تتوقف في أية لحظة. لذلك علينا أن نخطط على المستوى الحالي والقريب والبعيد، يجب على العامل أن يستغل كل وقت متاح في إمتاع نفسه (لكل طريقته في ذلك، لكن كل الأشياء التي تحقق المتعة والراحة النفسية مشروعة)، وفي الوقت نفسه التخطيط لمتع أكبر تكبر، ربما، مع توالي النجاحات، وربما التعثرات.
وأول الأشياء التي يجب عليه أن يحبها هي حب “عشية الأحد”. فالأحد نهاية وبداية، الأحد سيد الأيام (الأحد ليس يوما بذاته، فلكل عامل أحده الخاص). ومن يمتلك مخطط الأحد يمتلك مخطط الحياة والسعادة. إن كرهنا للعمل جعلنا نكره عشية الأحد لأنها تذكرنا بالغد، فننسى أن نعيشها. ففي اعتقادي أجمل لحظات الحياة هي عشيات الأحد، لأنها عشية تخطيط لما بعد المتعة، عشية رغبة جامحة في استحقاق متعة أخرى الأحد المقبل. من يُنجح أحده تنجح حياته. من يحب الأحد يعمل بقوة من أجله؛ والأحد طبعا قد يكون يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة. عندما نتعلم حب عشية الآحاد سنحب عملنا، وسنبحث عما نحبه، سنتخلص من القيود، سنستمتع بأوقات فراغنا كما شئنا، سنحب أنفسنا، وسنكون سعداء دوما.