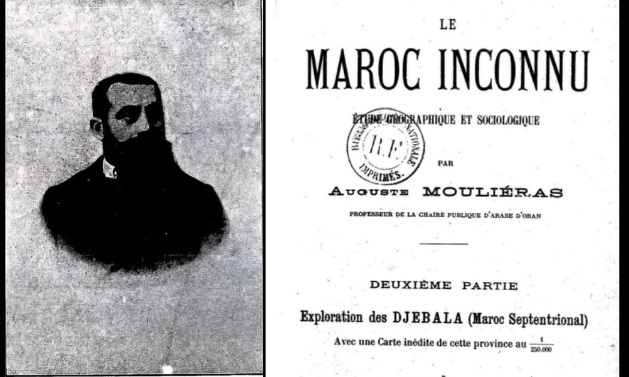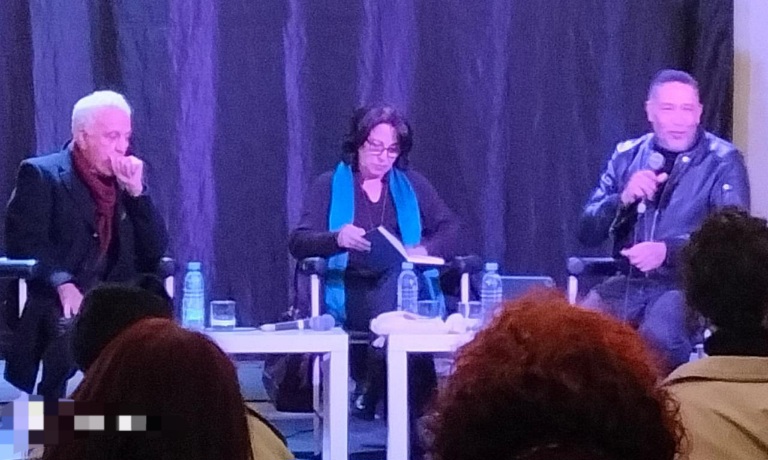لم يكن هذا القرار مجرد تقنين لتقويم شعبي متوارث، بل رسالة سياسية وثقافية واضحة تؤكد التزام الدولة المغربية بحماية هويتها المتعددة، وترسيخ الانتماء المشترك عبر الاعتراف بالمكوّن الأمازيغي كركيزة أصيلة من ركائز الهوية الوطنية. فهو تعبير عن رؤية متقدمة تجمع بين صيانة التنوع الثقافي، تعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على التراث غير المادي، بما يمنح الرمزية الثقافية مكانتها داخل السياسات العمومية، ويؤكد في الآن ذاته الدور الحيوي للمجتمع، والمرأة على وجه الخصوص، في حماية الذاكرة الجماعية ونقلها للأجيال.
لطالما لعبت الثقافة الأمازيغية دورًا محوريًا في تنظيم حياة الإنسان بشمال إفريقيا، وفي ترسيخ منظومة من القيم الاجتماعية والرمزية المرتبطة بالأرض والطبيعة والزمن. وقد ارتبطت هذه الثقافة، منذ آلاف السنين، بطقوس احتفالية دورية تعكس علاقة الإنسان بمحيطه الطبيعي، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من وعينا الجمعي وهويتنا الثقافية.
وإذا كان هذا الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية يحمل دلالات سياسية وثقافية معاصرة، فإن فهمه يقتضي العودة إلى سياقه التاريخي. فالسنة الأمازيغية التي نحتفل بها اليوم، والمقدّرة بـ2976 سنة، تقوم على قراءتين أساسيتين.
الأولى قراءة زراعية-طبيعية، إذ اعتمد الأمازيغ تقويمًا شمسيًا مرتبطًا بدورات الحرث والبذر والحصاد، استخدمه الفلاحون لتنظيم شؤونهم الحياتية وفق تغيّر الفصول، وهو تقويم عرفته شمال إفريقيا منذ العصور القديمة ولا تزال آثاره حاضرة في الممارسات التقليدية.
أما القراءة الثانية فهي قراءة رمزية-تاريخية، تبنّاها مثقفون ومنظّرون ثقافيون في القرن العشرين، وربطت بداية العدّ الأمازيغي بسنة 950 قبل الميلاد، تاريخ وصول الملك ششنق الأول، ذي الأصول الليبية-الأمازيغية، إلى حكم مصر القديمة. وقد منح هذا الاختيار للتقويم نقطة انطلاق ذات حمولة رمزية قوية في الذاكرة الثقافية الأمازيغية، دون الادعاء بوجود توثيق تاريخي صارم للتقويم بهذه الصيغة في العصور القديمة.
وهكذا، فإن التقويم الأمازيغي المعتمد اليوم هو نتاج تفاعل بين المعرفة الزراعية القديمة والرمزية التاريخية، وهو ما يعكس غنى التراث الأمازيغي وتعدد روافده، ويجعل من الاحتفال بـ«ينّاير» تجسيدًا لزمن ثقافي يمتد بين الطبيعة والتاريخ والهوية.
وتحضر الحكايات الشعبية بوصفها مرآةً لهذه العلاقة العميقة بين الإنسان ومحيطه. من ذلك حكاية «تامغرات»، التي تروي قصة امرأة عجوز اعتقدت أن الشتاء قد انتهى، فأخرجت قطيعها مستهزئة بشهر يناير، ليأتيها العقاب عبر يوم مستعار من فبراير، تعود فيه العواصف والبرد القارس. وتُستعمل هذه الحكاية، المتداولة شفهيًا في عدة مناطق، لتفسير التقلبات المناخية المفاجئة في نهاية الشتاء، في قالب بسيط وسهل الحفظ، يعكس ذكاء الثقافة الشعبية في تفسير الظواهر الطبيعية.
تبدأ طقوس الاحتفال بالسنة الأمازيغية قبل حلولها بأيام، حيث تنخرط الأسر في جمع الحطب والبذور وتبادلها بين الجيران، في تعبير رمزي عن التضامن وضمان الخصب القادم. كما يُنظَّف البيت تنظيفًا شاملًا، وتُشعل الأعشاب العطرية لطرد سلبيات السنة المنصرمة واستقبال السنة الجديدة بطاقة إيجابية.
وفي يوم الاحتفال، تتحول المائدة إلى فضاء رمزي بامتياز. يُحضَّر طبق «التاغولا» من دقيق الذرة أو الشعير، ويُخفى داخله حجر أو لوزة تُعرف بـ«أمناظ»، ليصبح العثور عليها فأل خير وحظ في السنة الجديدة. كما يُعدّ الكسكس بسبعة خضروات رمزًا لتنوع المحاصيل ووفرة الأرض، وتُقدَّم الحلويات والتمور والمكسرات، ويُترك جزء منها على المائدة كدعاء للرزق والبركة.
في قلب كل هذه الطقوس، تتجلّى مكانة المرأة الأمازيغية كحارسة للذاكرة وعمود فقري لاستمرارية الاحتفال. فهي التي تُعدّ الطعام وفق الوصفات المتوارثة، وتُشرف على ترتيب الفضاء المنزلي، وتنقل الأغاني والحكايات للأبناء، وتشرح لهم دلالات كل طقس. بذلك، لا تكون المرأة مجرد فاعلة داخل البيت، بل صانعة للمعنى، وناقلة للهوية عبر الأجيال.
ولا يقتصر دور المرأة على المجال الأسري، بل يمتد إلى الفضاء العام من خلال انخراطها في الجمعيات الثقافية وتنظيم الفعاليات المحلية، حيث تعمل كجسر بين الماضي والحاضر، وتعيد إنتاج التراث في ضوء التحولات الاجتماعية المعاصرة. إنها لا تكتفي بحفظ الموروث، بل تطوّره وتمنحه حياة جديدة، بما يضمن استدامته وانتقاله السلس بين الأجيال.
إن الاحتفال الرسمي بالسنة الأمازيغية اليوم يتجاوز بعده الاحتفالي، ليحمل رسالة استراتيجية تعيد رسم علاقة المجتمع المغربي بتاريخه وهويته المتعددة. فإقرار هذا اليوم كعطلة وطنية مدفوعة الأجر يندرج ضمن سياسة ثقافية شاملة تجعل من التنوع رافعة للوحدة الوطنية، وليس عامل انقسام. وهو مسار يتكامل مع الخطاب الملكي بأجدير، ومع دسترة اللغة الأمازيغية، وحضورها المتنامي في التعليم والمؤسسات.
لقد أصبح التقويم الأمازيغي أداة لإعادة قراءة تاريخنا الجماعي الممتد لأكثر من ثلاثة وثلاثين قرنًا، وتثمين حضارة ضاربة في عمق الزمن. فالسنة 2976 ليست مجرد رقم، بل تعبير عن وعي حضاري يربط الإنسان بالأرض والزمن، ويؤكد أن الحضارة الأمازيغية كانت ولا تزال جزءًا أصيلًا من الذاكرة الإنسانية.
نص مداخلتي خلال الحفل الذي نظمه حزب الحركة الشعبية يوم الأربعاء 15 يناير 2026، تحت عنوان:
«السنة الأمازيغية: قراءات في الدلالات والقيم».