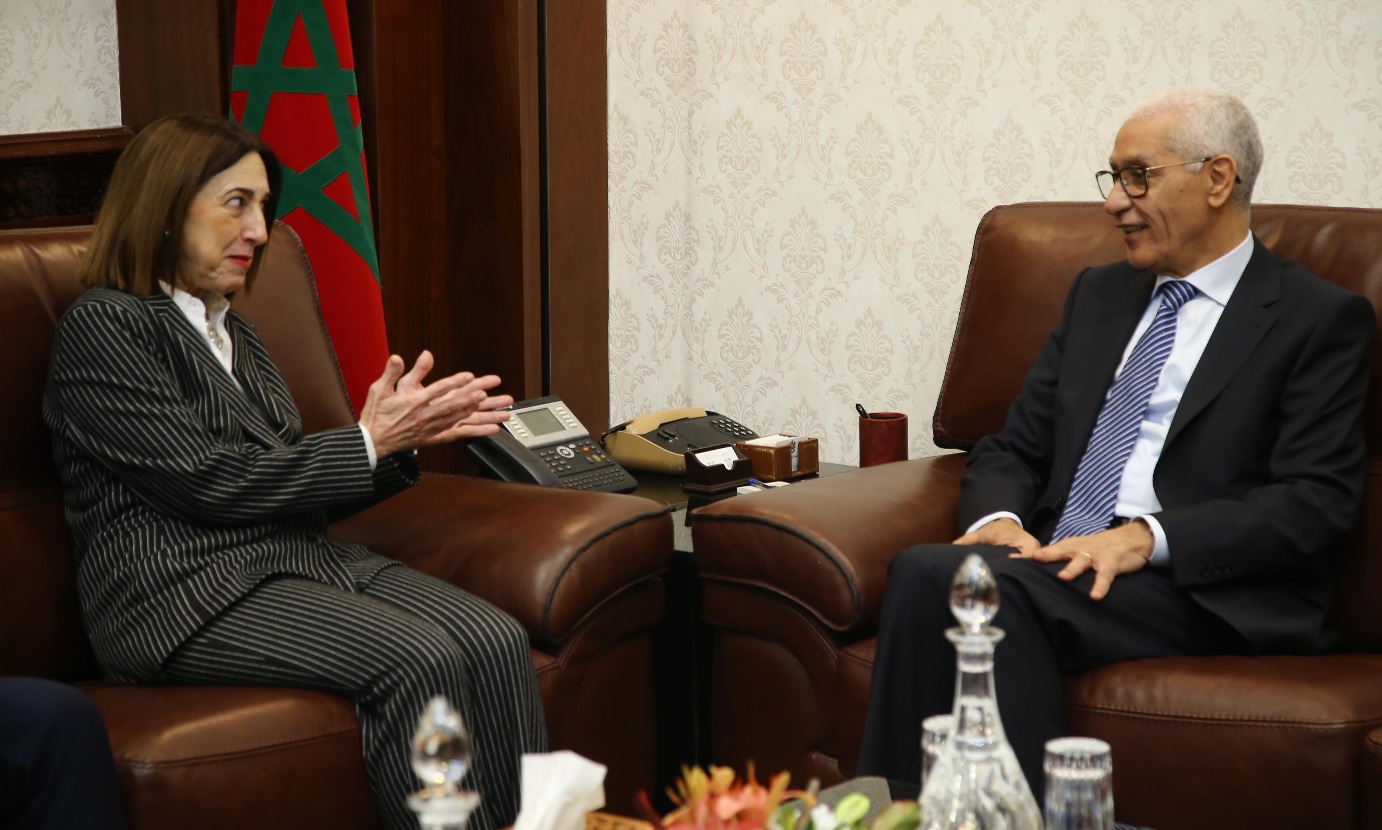نظرية المؤامرة تُوفر إجابة شاملة وبسيطة في آنٍ واحد. لا حاجة إلى تحليل البنى الاقتصادية، ولا إلى مساءلة التاريخ، ولا إلى نقد الذات الجماعية. كل شيء مُدبَّر سلفًا من قِبل "قوة خفيّة" تمتلك ذكاءً شيطانيًا وقدرة شبه مطلقة. بهذه السهولة، يتحوّل العالم من شبكة معقّدة من المصالح والأخطاء والتناقضات إلى حكاية واحدة ذات بطل شرير واحد.
هذا التبسيط ليس بريئًا. فهو يوفّر راحة نفسية عميقة للوعي المأزوم. فحين يفشل المجتمع في التنمية، أو تُهزم السياسة، أو تتكرّر الإخفاقات، يصبح من المؤلم الاعتراف بالخلل الداخلي. المؤامرة هنا تقوم بدور المُسكن: لسنا مسؤولين عمّا جرى، نحن فقط ضحايا. وهكذا يتحوّل الفشل من سؤالٍ نقديّ إلى قدرٍ خارجي، ومن مشكلة قابلة للإصلاح إلى مأساة كونية بلا فاعل واضح.
لكن أخطر ما في هذا المنطق أنه ينقل المسؤولية خارج الذات. فحين يُعزَى كلّ خلل إلى "الآخر المتآمر"، تتعطّل آليات المحاسبة، ويُعفى الفاعل المحلي من النقد، ويُغلق باب الإصلاح من الداخل. لا فساد يُناقَش، ولا رداءة تُفحَص، ولا بنية ثقافية تُراجَع. كلّ ذلك يُختزل في رواية مريحة: هناك من لا يريد لنا الخير !
إلى جانب ذلك، تمنح نظرية المؤامرة أتباعها شعورًا زائفًا بالتميّز. المؤمن بها لا يرى نفسه جاهلًا، بل عالما بالأسرار، يرى ما لا يراه الآخرون. وهكذا يتحوّل الشك الوسواسي إلى حكمة عميقة، والتوجس المرضي إلى هوية راسخة، ورفض الأدلة إلى شجاعة أخلاقية.
سياسيًا، تفضي هذه الرؤية إلى شللٍ عميق. فإذا كان كل شيء مُحكَم السيطرة، وكل المسارات مرسومة سلفًا، فما جدوى الفعل؟ لماذا نُكافح، أو نُصلح، أو نراكم وعيًا، إذا كان التاريخ يُدار في غرفٍ مظلمة لا يصلها صوت الناس؟ هكذا تُقنعك المؤامرة، من حيث لا تصرّح، بأن الجهد الذاتي عبث، وبأن المبادرة الفردية وهم. وبهذا النحو فإنها تنتج غضبًا مشلولًا، واستقالةً صامتة من حركة التاريخ، تتخفّى في هيئة وعيٍ غاضب ومعرفةٍ بديلة.
وليس من المصادفة أن تجد الأنظمة الاستبدادية في نظرية المؤامرة حليفًا طبيعيًا. فهي توفّر لها تبريرًا جاهزًا للفشل، وتمنحها أداة فعّالة لتجريم النقد، وتحويل كل مساءلة إلى خيانة، وكل اختلاف إلى عمالة، وكل صوت مستقل إلى تهديد للأمن القومي أو خروج عن الملة والدين.